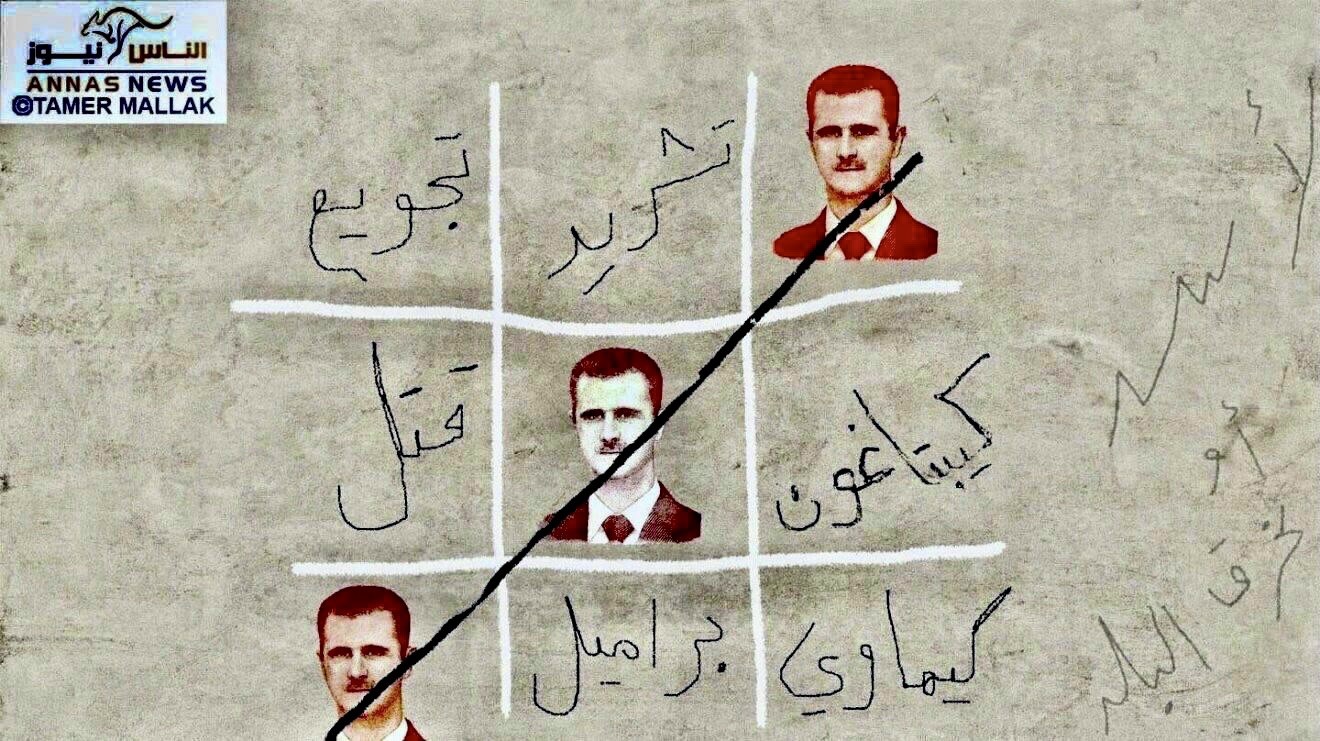ميديا – الناس نيوز ::
المدن – لم تدخل بثينة شعبان القصر الجمهوري بوصفها واحدة من صانعي القرار، ولا باعتبارها جزءاً من مطبخ السلطة الصلب، بل دخلته حاملةً لغة. لم تكن ضابطاً في جهاز، ولا كادراً حزبياً صلباً، ولا ابنة منظومة أمنية متجذّرة، بل أكاديمية تعرف كيف تُصاغ الجملة، وكيف يُخفَّف المعنى، وكيف تُدار الكلمات حين تعجز الوقائع عن الدفاع عن نفسها.
كانت وظيفتها الأساسية أن تمنح النظام صوتاً قابلاً للعرض، وأن تصوغ روايته بعبارات أقل فجاجة، وأكثر قابلية للتداول خارج حدوده. ولهذا السبب تحديداً، بدا حضورها طويلاً في الزمن، لكنه ظلّ هشّاً في الجوهر؛ ممتدّاً شكلياً، ومؤقتاً وظيفياً في آن واحد.
ففي نظام لا يُدار بمنطق التراكم، ولا يعترف بالخبرة بوصفها قيمة مستقلة، يصبح الدور مرتبطاً بالحاجة الآنية لا بالمسار.
وحين تنتفي الحاجة، ينتفي الدور تلقائياً، مهما طال زمن الخدمة، ومهما بدت المكانة راسخة. في مثل هذه البنى، لا يُقاس النفوذ بما قُدِّم في الماضي، بل بما يمكن تقديمه الآن، وهنا فقط يُعاد توزيع الأدوار، أو يُسحب بساطها بصمت.
مثقفة في بلاط السلطة.
برز اسم بثينة شعبان في تسعينيات القرن الماضي، في لحظة دقيقة من تاريخ النظام السوري. كانت البلاد خارجة من عزلة سياسية خانقة، وتبحث عن مخارج ناعمة إلى العالم الغربي، من دون تقديم أي تنازل حقيقي في بنية الحكم. احتاج النظام حينها إلى وجوه تتقن لغة الآخر، وتفهم حساسيته، وتستطيع مخاطبته من دون أن تهدد جوهر السلطة.
جاءت بثينة من هذا الباب.
أستاذة أدب إنكليزي، حاصلة على تعليم عالٍ في بريطانيا، ومتمرّسة في الخطاب الأكاديمي الغربي. لم تُستدعَ لتقترح سياسات، بل لتشرح سياسات قائمة، وتقدّمها في قالب أقل فجاجة. كانت وظيفة “الترجمة السياسية” بامتياز: نقل خطاب النظام إلى لغة مقبولة دولياً، لا إعادة النظر فيه.
وجودها قرب السلطة لم يكن دليل نفوذ، بل دليل وظيفة. كانت قريبة بالقدر الذي يسمح لها بالكلام، وبعيدة بالقدر الذي يمنعها من القرار. وهذا التوازن الدقيق هو ما سمح لها بالبقاء طوال سنوات حكم حافظ الأسد، من دون أن تتحوّل إلى عبء أو تهديد.
ماكينة ترويج سياسية
مع انتقال السلطة إلى بشار الأسد عام 2000، تغيّر المشهد السياسي، وتغيّرت معه الحاجة إلى الخطاب. الرئيس الجديد، الذي قُدِّم بوصفه طبيباً شاباً متعلّماً في الغرب، احتاج منذ اللحظة الأولى إلى واجهات تُعزّز هذه الصورة، وتُسهم في تسويق مرحلة يُراد لها أن تبدو مختلفة في الشكل، إن لم تكن في الجوهر. في هذا السياق، انتقل دور بثينة شعبان من الهامش الثقافي إلى قلب المشهد الإعلامي الرسمي.
عُيّنت مستشارة سياسية وإعلامية في القصر الجمهوري، وظهرت بكثافة لافتة في وسائل الإعلام العربية والغربية، بوصفها أحد الأصوات الأكثر حضوراً في شرح مواقف السلطة الجديدة. كانت تتحدّث عن “الإصلاح”، و”التدرّج”، و”خصوصية التجربة السورية”، مستخدمة لغة محسوبة تحاول الجمع بين خطاب الانفتاح ومتطلبات الضبط السياسي. قدّمت نفسها كصوت عقلاني داخل نظام يوحي، في تلك المرحلة، بأنه في طور التحوّل والإصلاح، لا القطيعة أو الصدام.
غير أن هذا الاتساع في الحضور الإعلامي لم يكن مقروناً بسلطة حقيقية داخل بنية الحكم. فبثينة شعبان لم تشارك في صناعة القرار، بل في شرحه وتبريره. كانت جزءاً من ماكينة ترويج سياسية، لا من مطبخ الحكم الفعلي حيث تُتّخذ القرارات الحاسمة. ومع ذلك، بدت في تلك السنوات في ذروة حضورها الرمزي، حين كانت تُستدعى لتفسير كل خطوة، وتبرير كل تعثّر، وتلطيف صورة سلطة تسعى إلى إعادة تعريف نفسها من دون المساس بأسسها.
زمن الاصطفاف الحاد
شكّلت انتفاضة آذار/مارس 2011 لحظة فاصلة في مسيرة بثينة شعبان، كما في مسار النظام نفسه. فمع خروج الاحتجاجات إلى الشارع، انتهى زمن الخطاب الرمادي، وسقطت الحاجة إلى اللغة الموارِبة، ليبدأ زمن الاصطفاف الحادّ والخطاب الأحادي. في تلك اللحظة، تحوّلت المستشارة “الناعمة” إلى مدافعة صلبة عن السلطة، وانتقلت من موقع التفسير إلى موقع التبرير المباشر.
تبنّت بثينة رواية النظام كاملة، من دون مواربة أو تحفّظ: مؤامرة خارجية، مجموعات مسلّحة، حرب على الدولة. ظهرت في مقابلات دولية لتبرير العنف، وقدّمت القمع بوصفه دفاعاً عن الاستقرار، وأعادت إنتاج السردية الرسمية بلغة موجّهة إلى الخارج، لا تقلّ حدّة في مضمونها عن خطاب الداخل. لم تترك مساحة للالتباس، ولم تحاول الاحتفاظ بأي مسافة نقدية، بل اختارت الاصطفاف الكامل، سياسياً وأخلاقياً.
غير أن المفارقة تمثّلت في أن هذا الولاء الخطابي لم يُترجم إلى نفوذ فعلي داخل بنية الحكم. فمع تحوّل البلاد تدريجياً إلى ساحة حرب مفتوحة، تغيرت أولويات النظام، وتبدّلت أدواته. لم يعد بحاجة إلى مثقفين يشرحون، أو إلى وجوه تبرر، بقدر ما احتاج إلى أجهزة تنفذ، وتُحكم السيطرة، وتدير الصراع بمنطق أمني ــ عسكري مباشر. عند هذه النقطة تحديداً، بدأ دور بثينة شعبان يفقد معناه الوظيفي، حتى وهي في ذروة حضورها الإعلامي، وحين كان صوتها لا يزال يُستدعى لتغطية واقع بات يُدار خارج اللغة.
التراجع
ابتداءً من منتصف العقد الماضي، بدأ تراجع بثينة شعبان يتبلور تدريجياً، وإن من دون إعلان رسمي أو قرار معلن. جاء هذا التراجع متزامناً مع صعود أسماء جديدة داخل الدائرة الضيقة المحيطة بـ بشار الأسد، كان أبرزها لونا الشبل، التي سرعان ما فرضت حضورها بوصفها أحد الوجوه الأكثر قرباً وتأثيراً في إدارة الخطاب الإعلامي للنظام.
لم تكن لونا الشبل امتداداً لدور بثينة شعبان، ولا تطويراً له، بل شكّلت نقيضه الوظيفي الصريح. فهي إعلامية سابقة، أكثر حدّة في الخطاب، وأقل اكتراثاً بصورة النظام في الخارج، وأكثر انسجاماً مع مناخ الحرب المفتوحة الذي دخلته البلاد. لم يكن مطلوباً منها تلطيف اللغة أو تجميل السردية، بل تشديدها وضبطها. لم تكن مهمتها الشرح أو الإقناع، بل السيطرة على الرسالة، وتوحيدها، ومنع أي ارتباك في نقلها.
الفارق الجوهري بين المرأتين لم يكن في الكفاءة الشخصية أو المهنية، بل في الموقع داخل بنية السلطة. بثينة كانت تُستدعى عند الحاجة، وتُستخدم بوصفها صوتاً تفسيرياً يُعاد تشغيله عند الأزمات. أما لونا، فأصبحت جزءاً من اليوميات السياسية والإعلامية، من صناعة الرسائل لا من شرحها، ومن إدارة المنصّات لا من الظهور عليها فقط، ومن الإشراف المباشر على الإعلام الرسمي وشبه الرسمي. ومع هذا التحوّل البنيوي في وظيفة الخطاب، بدأ نفوذ بثينة شعبان يتآكل بصمت، لا عبر صدام أو إقصاء معلن، بل عبر سحب بطيء للدور، وإعادة توزيع للأدوار داخل القصر.
الإقصاء بلا قرار
لم يُعلن عن إقالة بثينة شعبان، ولم يصدر أي قرار رسمي بتجريدها من منصبها. غير أن ذلك لم يكن يعني، بأي حال، أنها بقيت فاعلة. على العكس، جرى تحييدها وفق الأسلوب الذي يتقنه النظام أكثر من أي شيء آخر: الإبقاء على اللقب، وسحب الدور.
في هذه المرحلة، لم تعد بثينة “المستشارة”، بل غدت الخادمة القديمة، تلك التي أدّت ما طُلب منها على امتداد سنوات طويلة، ثم وُضِعت جانباً حين تغير المزاج، وتبدلت الحاجة، ودخلت أدوات أكثر انسجاماً مع المرحلة الجديدة. لم يكن مطلوباً كسرها علناً، ولا إحراجها، ولا حتى تبرير إبعادها. كان يكفي أن تُسحب منها الملفات، وأن تُغلق قنوات الوصول، وأن تُترك داخل القصر بوصفها اسماً من الماضي.
هكذا بقيت بلا قرار، ولا قدرة على التأثير. وكما صرّح مصدر لـ”المدن”، لم تعد تمتلك رفاهية فرض أشخاص، ولا الاستفادة من أي شيء.
تدريجياً، اختفت من المشهد الإعلامي، وغابت عن المؤتمرات والوفود، ولم تعد تُستشار في القضايا الأساسية. تحوّلت من “صوت النظام” إلى شاهد صامت على نظام لا يحتفظ بخدامه بعد انتهاء صلاحيتهم. وهذا الشكل من الإقصاء هو الأكثر شيوعاً في بنية الحكم السورية: لا مواجهة، لا فضيحة، فقط نسيان متعمد.
فالسلطة هنا لا تعاقب الخادمة القديمة، بل تتجاوزها. لا تُقصيها بوصفها خطراً، بل تُهمّشها بوصفها فائضاً عن الحاجة. وفي نظام كهذا، يكون النسيان أقسى من الإقالة، وأكثر دلالة على طبيعة الحكم ومنطقه.
هل بثينة شعبان ضحية؟
من السهل تقديم بثينة شعبان بوصفها ضحية صراع نفوذ داخل القصر، غير أن هذا التوصيف يظل ناقصاً ومضلِّلاً. فبثينة لم تُقصَ لأنها اعترضت، ولا لأنها حاولت تغيير المسار، ولا لأنها خرجت عن الخط العام. على العكس، كانت جزءاً أساسياً من ماكينة الخطاب التي بررت القمع، وغطت الجرائم، وأسهمت بوعي في تثبيت سردية رسمية قائمة على الإنكار ونفي المسؤولية.
ومع ذلك، تبقى قصتها كاشفة. فهي تبيّن، بوضوح، كيف يتعامل النظام مع أدواته حين تستنفد وظيفتها. يستخدمها إلى حد الاستهلاك، ثم يستبدلها عندما تتغير المرحلة وتتبدل الأولويات. لا ولاء طويل الأمد يُكافأ، ولا ذاكرة مؤسسية تحمي، ولا قيمة لتاريخ شخصي مهما طال زمن الخدمة. في هذه البنية، لا يُقاس الدور بما قُدِّم في الماضي، بل بمدى صلاحيته للحاضر فقط.
حين تنتهي الوظيفة ينتهي صاحبها
قصة بثينة شعبان ليست استثناءً، بل تجسيداً لقاعدة راسخة في نظام قائم على الاستخدام لا على الشراكة. دخلت القصر لأنها كانت مفيدة في لحظة معينة، وبقيت لأنها لم تكن مزعجة أو مُكلفة، وخرجت من المشهد لأنها لم تعد ضرورية. لم تُطرَد، ولم تُدان، ولم تُكرَّم. لم يصدر بحقها بيان، ولا جرى توديعها، بل اختفت ببساطة، كما يختفي كل من تنتهي وظيفته في منظومة لا تعترف بالمسار ولا تحتفظ بالذاكرة.
في سوريا، هذا هو الشكل الأكثر قسوة للإقصاء: أن تتحول من صوت يُسمَع ويُستدعى عند الحاجة، إلى اسم لا يُذكر، ومن دور يُعاد تشغيله عند الأزمات، إلى هامش صامت خارج الحسابات. هكذا تُغلق الدوائر في بنية حكم لا تعرف الوفاء، ولا تكافئ الخدمة، بل تستبدل أدواتها كلما تغيّرت المرحلة.



الأكثر شعبية

ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”

إياد كوجان أحد رواد الأعمال يطور قصة نجاح شركته thermo trade