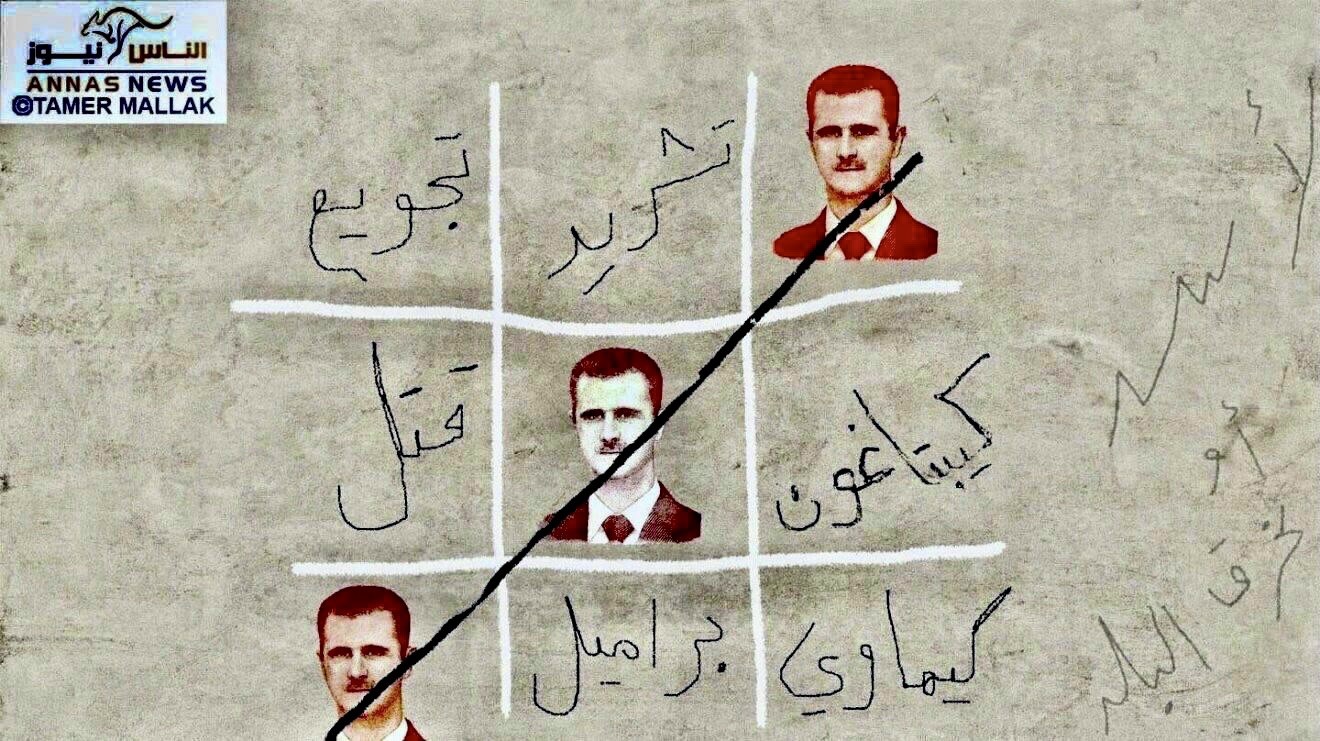د . محمد حبش – الناس نيوز ::

بدءاً من حرب حلايب في الألف العاشر قبل الميلاد بين السودان ومصر وهي أقدم الحروب التي رصدها علماء الآثار، حيث اكتشفت بقايا مقبرة جماعية ل 117 شخصاً قتلوا في تلك الحرب الغامضة، مروراً بحروب العصور القديمة والحروب الوسطى والفتوحات والاستعمار والحروب الدينية والاستعمار والحروب العالمية، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية وحرب غزة يعتقد كاتب هذه السطور أن فكرة شريرة كانت دوماً وراء هذه الحرب وأشعلت نيران كل الحروب ، وهي عقيدة (الكلي الشر)، الآخر كلي الشر، ولا يوجد طريقة لاستمرار الحياة إلى الإيغال في الحرب!

الكلي الشر هو شرط أساسي لحشد الناس للحرب، فلولا أن الناس آمنت بأن العدو كلي الشر لما احتشدت للقتال، ولولا أن خطباء الحرب أقنعوا الناس بأننا أمام حرب وجود اقتل أو تقتل، وأن علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد إرادة شريرة لا ينفع معها إلا القتل والدم لما وقعت هذه الحروب أصلا.
حتى المجرم الصهيوني اليوم يحشد جيشه وحلفاءه في العالم بعقيدة المظلومية هذه في مواجهة كلي الشر وهو هنا الفلسطيني الثائر الذي أطلق في مواجهة الظلم صيحات تدعو إلى إبادة اليهود، وهكذا فإنه لا حل مع هذا العربي إلا بالقتال إلى النهاية، وهو حل يتناوسون في طرحه موثقاً يطرحه زعماء المقاومة بالصوت والصورة، وذلك ليتم تبرير الاجتياح والقصف والتدمير وحصار المشافي وتدميرها، على أنه ضرورة حتمية لمواجهة كلي الشر، ولكن أصدقهم في التعبير عن موقفه من كلي الشر هو الوزير المجرم ابن غفير الذي أعلن بوضوح أن أفضل حل لمواجهة الكلي الشر هو القصف بالقنبلة النووية ورمي غزة في البحر !!!
ولكن حركات المقاومة أيضاً تنطلق من الأرضية نفسها، ولا ترى في الآخر إلا كلي الشر، وترى أيضاً كما يرى أعداؤها أن الله خلق العالم محنة للمجاهدين الصابرين من أهل الحق ليواجهوا أهل الطاغوت وأنه صراع قدري حتمي مستمر منذ فجر التاريخ إلى قيام الساعة، ولا نهاية له إلا باستئصال العدو، أو بقيام الساعة!!.
الإرادات المتقابلة نقتلهم أو يقتلوننا، حرب الوجود، الله والشيطان، الخير والشر، من وجهة نظري إطلاقيات بائسة، تقدم تفسيراً تبريرياً تعيساً للتاريخ، ولكنها لا تنهي أي مشكلة ولا توقف أي جريمة، ولا تبني أي شكل من السلام، وهي وقود الحرب وفيوله كلما أطفأ الله حرباً أوقدوها بثقافة الكلي الشر.

في الحالة الفلسطينية والإسرائيلية لا يوجد أي حل على الإطلاق لثقافة الكلي الشر، لا هنا ولا هناك، وقدر هذه المنطقة أن تغلي في أتون الحرب إلى قيام الساعة، وأفضل ما يفعله العاقل أن يرحل بنفسه وأهله من هذه البلاد إلى بلاد الله الواسعة، وهو بالفعل ما فعله مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لا يؤمنون بالحرب ويؤمنون بالسلام وباتوا يعيشون في أطراف موزعة من العالم بثقافة مختلفة وروح جديدة.
تصر هذه الورقة أنه لا وجود لكلي الشر في العالم، وأن الآخر الذي نقاتله على الرغم من توحشه وافتراسه كان يمكن أن يكون أقل توحشاً او قل عدوانية وجريمة لو أننا نجحنا في رفع خطاب السلام والعيش المشترك وغيبنا خطاب الكراهية.
فلسطين بلد كسائر بلاد الله، سكنتها أمم وشعوب واديان مختلفة، ونظرت الشعوب إلى القدس كمدينة للصلاة والسلام خلال التاريخ، وفي تقرير وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن اليهود عام 1917 قبل بلفور كانوا 94 ألف يهودي يعيشون بسلام في هذه الأرض، وقد حاولوا التخطيط لحكم ذاتي تحت ظل الخلافة أيام السلطان عبد الحميد وباءت محاولاتهم بالفشل، فاحتضنت بريطانيا المشروع عبر وعد بلفور البريطاني، وللأسف لقد كانت هذه الوعود غدراً بالعيش المشترك في فلسطين وفي غياب أي رأي لسكان الأرض من فلسطينيين وحتى لليهود المحليين، بدأ مشروع عالمي يتبلور للخلاص من اليهودي التائه في أوربا ونقل الكارثة والمشكلة كبضاعة غير مسجلة إلى الشرق الأوسط.

في ظروف كهذه نمت عقيدة الكلي الشر، ولم ير العربي في اليهودي إلا كلي الشر، المجرم المفطور على الشر، وأنهم قطعان هجانة هائجة موتورة تقيم تجمعها على جماجم الآخرين ومآسيهم ومذابحهم، ولا حل مع هذه القطعان إلا بمنطق اقتلوهم حيث ثقفتموهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب.
وهذه العقيدة نفسها عقيدة كلي الشر نظرها الصهيوني أيضاً للعربي حيثما كان، وهي عقيدة وفرت لإسرائيل تبريراً لأبشع الجرائم التي ارتكبت على أرض فلسطين من مجزرة دير ياسين وكفر قاسم والنكبة والنكسة والاجتياح وهي مصطلحات ترتبط بشكل واضح بالمجازر التي لم تتوقف خلال التاريخ في أرض فلسطين، وغابت نصوص الرحمة والتسامح من العهد القديم وباتت سورة أشعيا أم الكتاب وفيها أسرار التوراه، وفيها يأمر أشعيا رجال الرب بأن يدمروا فلسطين وأن لا يذروا فيها طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً عجوزاً، وتختتم عبارات هذا النبي المجرم بقوله: ولولي يا فلسطين فالرب أمرنا أن نقل كل أبنائك ليحل مكانهم شعب الله!!!!
ولمن يريد أن يقرأ النص التوراتي بحروفه فهو موجود في كل نسخة من الكتاب المقدس في سفر أشعيا:
15- كُلُّ مَنْ وُجِدَ يُطْعَنُ، وَكُلُّ مَنِ انْحَاشَ يَسْقُطُ بِالسَّيْفِ.
16 – وَتُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ أَمَامَ عُيُونِهِمْ، وَتُنْهَبُ بُيُوتُهُمْ وَتُفْضَحُ نِسَاؤُهُمْ.….
30 – وَلْوِلْ أَيُّهَا الْبَابُ. اصْرُخِي أَيَّتُهَا الْمَدِينَةُ. قَدْ ذَابَ جَمِيعُكِ يَا فِلِسْطِينُ
وهذه النظرية عبر عنها في النهاية وزير الحرب ورئيس الوزراء الصهيوني إسحق شامير بقوله: العربي الصالح الوحيد هو العربي الميت!!!
تمضي هذه المقالة إلى التأكيد بأن نظرية كلي الشر خرافة، يمكن التغلب عليها ببناء ثقافة المعاذير وفهم مقاصد الآخرين واحتياجاتهم، وأنه لا وجود لكلي الشر، حتى ما تشير إليه دراسات علم النفس من ظاهرة الإنسان المجرم كما تبناها لامبروزو فهي لا تجيب على شيء من المأساة التي نحن فيها، فليس للمحارب الصهيوني معالم بيولوجية متقاربة، بل تجمعهم رؤية سوداء لئيمة قائمة على أن العربي كلي الشر، وأن سبيل الخلاص هي سبيل واحدة ، وهي القتال العسكري الطاحن، وهي النظرية نفسها التي يتبناها الخطاب العربي المقاوم، إذا لا شيء يمكن أن تواجه به هذه الدولة المدعومة أمريكياً إلا العمل الحربي الباطش، وسيعتبر المحاربون البائسون أن الطريق لا بد أن يكلفنا ملايين الشهداء، وهذه إرادة الله الغالبة ولا حل إلا بالدم والرصاص والموت.
في تاريخ الصراع العربي الصهيوني استثناءات نادرة وقليلة وأبرزها بالطبع أنور السادات وإسحق رابين فقد وصل الرجلان إلى قناعة أن كلي الشر خرافة، وأن للعرب كما لليهود مطالب إنسانية وطبيعية في هذه الأرض، وفي لحظة وعي شجاعة تقدم الرجلان ووقعا اتفاق السلام برعاية جيمي كارتر، ولكن الأفراح لم تستمر طوبلاً، فقد قتل التطرف الإسرائيلي إسحق رابين وقتل التطرف الإسلامي أنور السادات، وعادت الكرة مرة أخرى في ملاعب الكلي الشر!!.

لحظات نادرة هي تلك التي تبادل فيها الطرفان شعور الحق بالحياة والحق بالاختلاف، وأدركوا فيها أنه ما من سبب يجعلنا نفهم الآخر على أنه كلي الشر، وأنه يمكننا تدوير الزوايا، وتقاسم الأرض والعيش بسلام.
أعلم جيداً أن طرح مثل هذه الأفكار في لحظات الحرب الهائجة هو لون من السذاجة والدروشة، إن لم يقل بعضهم إنها عمالة وارتهان، ولكنها عقيدتي ويقيني، وأنه لا يوجد نهاية لهذه الحرب المجنونة إلا بنشر ثقافة الإيمان بحق الآخر في الحياة، ورفض الفكرة المسمومة أن الآخر كلي الشر، وهو ما يعبر عنه سياسياً بمبدأ حل الدولتين، وبناء شكل من القبول والتعايش على هذه الأرض أياً كانت طبيعة الكراهية والبغضاء التي كرستها السنون اللئيمة.