لميس الزين – الناس نيوز ::

حظيت قضية مظلومية المرأة مع الرجل على مدى العقود الماضية بالكثير من الأقلام النسوية المنافحة، حققت خلالها مكاسب كثيرة وهو إنجاز يحتسب لها، فهل بقي قطار النضال من أجل حقوق المرأة على السكة نفسها أم تجاوزها وخرج عنها إلى طريق لم تكن المقصد؟
لوحظ مؤخراً ارتفاع نسبة الطلاق بين اللاجئين السوريين الذي انتشر حتى تحوّل إلى ظاهرة، وعلت الأصوات الذكورية تعزو طلب المرأة للطلاق بعد وصولها أوربا إلى صفات الخيانة والغدر النسائيين، ورغبة في التفلُّت كشفت عن نفسها ما إن وجدت لها فرصة، وبتحريضٍ ممَّا يسمَّى النَّسويّة.
موقف آخر جاء على خلفية ما انتشر من تفاصيل الخلاف بين جوني ديب وزوجته آمبر هيرد، وانقسام متابعي القضية بين مناصرين للزوج ومدافعين عن الزوجة، فانطلقت تعليقات تتّهم من يدافع عن الزوج بالعقلية الذكورية المتسلّطة، باختصار لكي تكون متحضراً ومتخلّصاً من رواسب شرقيّتك فعليك أن تناصر المرأة مظلومة كانت أو ظالمة، وقبل أن تعرف الملابسات.

مواقف كهذه تستفز مناهضي الحركة النّسويّة ومحاربيها، وتجدِّد اتّهامها بالوقوف وراء انتشار حالات الطلاق والتفكُّك الأسريّ. فما هي النّسويّة؟ كيف بدأت؟ وهل يُعتبر ما حقَّقته إنجازاً أم إفساداً؟
ظهر مصطلح النّسويّة في الجامعات الغربية نهاية الستينيات مع نشر أبحاث أكاديمية عنيَت بكشف التمركز الذكوري الذي همَّش النساء وحرمهن حقوقهن وأنكر إسهاماتهن وفعالياتهن، كما كشف الهيمنة الذكورية على عمليات بناء المعرفة والعلوم عبر التاريخ.
لكن جذور الحركة تعود لأبعد من ذلك، حيث تعتبر ماري وولستوكرافت مؤلفة كتاب “دفاعا عن حقوق المرأة” 1792 هي مؤسِّسة النَّسويّة، إذ طالبت في كتابها بتعليم المرأة، أما مصطلح النسوية أو feminism فأول من أطلقه الفيلسوف الفرنسي شارل فورييه عام 1837″féminisme”.
تطورت الحركات النّسويّة على أربعة مراحل، ظهرت الموجة الأولى في القرن التاسع عشر، سَعَتْ لتحقيق المساواة السياسية والقضائية، فطالبت بحقِّ المرأة في التصويت وظروف عملٍ عادلة.
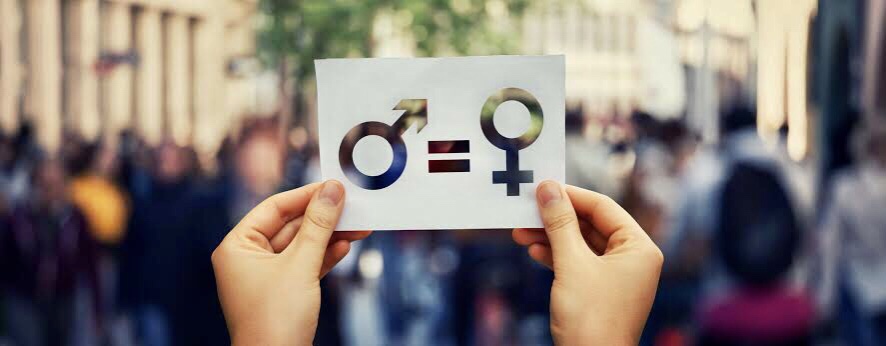
فيما ركَّزت الموجة الثانية على أشكال التمييز ضدّ المرأة والعنف ضدها في سائر المستويات، وقد تبنَّتها الفرنسية سيمون دي بوفوار في كتابها “الجنس الآخر” تقول: “لا تولد المرأة امرأة، إنها تصبح كذلك” لتؤكد برأيها هذا على دور التنشئة في التربية الجندرية.
اهتمَّت الموجة الثالثة بفكرة “طبقات الاضطهاد”، بمعنى أن النساء قد يعانين من تمييز بسبب الجنس والعِرق والطبقة معا. أما الموجة الرابعة فذهبت أبعد في الدعوة للتحرّر من أي قوالب نمطيّة مسبقة مرتبطة بالفكر الجندري، فهي كما وصفتها د.هند الشلقاني “تمعِن في المطالبة بحقوق المهمّشين والعابرين جنسياً، وتتحدث عن حقوق الرجال والأولاد أيضاً في تجاوز القوالب المفروضة عليهم”.
شهد الشرق أيضاً حراكاً نسويَّا قادته رائدات من أمثال الكاتبة المصرية عائشة تيمور (1840-1902) التي اتَّسم خطابها بنسوية ذات طابع إسلامي، فهي ترى أن النظام الإسلامي لا يشجّع على التمييز، بل إنه قائم على العدل والإنصاف.

والكاتبة ملك حفني ناصف (1886-1918) المسماة “باحثة البادية” تحدثت في كتابها “النسائيات” عن قضايا تحرير المرأة والمطالبة بحقوقها. كما تزامن ظهور مصطلح النسوية الإسلامية مع صدور مجلة “زنان” (وتعني امرأة باللغة الفارسية) في إيران عام 1992، والتي أسستها الصحفية شهلا شركت، التي تعتبر من رائدات حقوق المرأة في طهران.
بالنسبة للحركات النّسويّة في العالم العربي، لا يمكننا تعميم وصف موحد على الجميع، فلكلِّ حركةٍ سماتها بسبب الواقع السياسي والاجتماعي المختلف لكل بلد، وما مرت به الحركات من انقطاعات بسبب الحروب والأزمات وهيمنة التيارات المتشدّدة في بعض البلدان، لكن يمكننا القول إنها جميعا ومنذ بدايات هذه الحركة في نهاية القرن التاسع عشر، لقيت صدوداً من جزء كبير من المجتمع، إذ اعتُبرت تهديداً للتوزيع التقليدي للأدوار بين الرجل والمرأة، وخطراً على الهوية والمنظومة القيمية.
واتُّهمت بالسعي إلى خلخلة ثوابت الدين والتآمر على استقرار المجتمع.

ولا تزال هذه التُهم قائمة إلى اليوم، تتجدد بتجدد الدعوة إلى المساواة، كما حصل في تونس بعد تقرير “لجنة الحريات الفردية والمساواة” حول المساواة في الإرث.
لقد كان للحراك النّسوي في مرحلة ما دورٌ ضروري وفعَّال، بعد قرون من التجهيل ومن حرمان المرأة ممارسة أبسط حقوقها كالتعليم، وترسيخ مفاهيم مغلوطة عن قوامة الذكر على الأنثى متجاهلين أنها قوامة تكليف لا قوامة تشريف، فاجتُزئت على سبيل المثال آية “الرجال قوّامون على النساء” من سياقها الذي ربطها بإنفاق الرجل عليها “بما أنفقوا” (النساء 34).
لا تستقيم الحياة من دون أيٍّ منهما…
لكن الذي حصل وما نراه مؤخرا أن الكثير من الحركات النسوية قد استمرأت المضيّ في مسعاها أبعد من المطلوب، رغم تغيّر الزمن وتبدّل الظروف. فمن استعادة حقوق المرأة المهدورة إلى ربط استقلالية المرأة وتحقيق ذاتها بالاستغناء عن الرجل الذي هو مكمّل للمرأة، ولا تستقيم الحياة من دون أيٍّ منهما.
لقيت تلك الدعوات صدى لدى الكثيرات، ممن لا يملكن الثقافة الكافية للتمييز بين قوة الذات وتقليل احترام الآخر، بين تحصيل الحقوق الذاتية وانتهاك حقوق الشريك، حتى وصلنا في بعض الحالات إلى ضرورة مطالبة المرأة بحقوق الرجل، ناهيك عن مصلحة الأبناء الضائعة بين أروقة المحاكم وقضايا الحضانة.
هل تمَّ ذلك جهلا أم بتحريض خارجي ( البعض حاضرة في ذهنه نظرية المؤامرة ) ؟ لا يمكن الجزم، لكن الواضح أن لدى قسم من النّسويات أفكار موتورة تنمُّ عن خللٍ نفسيّ وعدم نضج عاطفي.

بالمجمل فإن المرأة في مجتمعاتنا اليوم مضطهدة بالقدر المضطهد فيه الرجل في بلاد لا كرامة فيها لمواطن، ذكراً كان أو أنثى، لا يخلو الأمر من شريحة ماتزال المرأة مقموعة فيها، عدا ذلك فمعركة المرأة مع نفسها وليست مع الرجل، والفوز فيها هو التغلب على الظروف القاهرة التي تتعرض لها سواء بسواء مع الرجل.
وعليه فحقوق المرأة لا تحل بالكتابة عن مظلومية المرأة وإنما برفع سوية ثقافتها، ولا أقصد هنا الثقافة العامة فقط علميّةً كانت أم أدبيّة، وإنما وعيها بحجمها الطبيعي كعنصر في مجتمع يحوي الذكور ويحوي الإناث ولا فرق بينهما إلا فيما يخص الجانب الجندري، والعلاقة التي تربطها بالرجل، وهي علاقة تكامل وليست ساحة نزاع، هو شريك لها وليس ندّاً.
وعلى التربية يقع عبء تصحيح تلك المفاهيم بكافة أشكالها بدءاً من الاختيار الصحيح لشريك الحياة على أسس سليمة بعيدة عن المظاهر والقشور، وصولا للتعامل مع المرأة على أساس من الحب والتفاهم والاحترام، وليس التضييق والإلزام، لأن تلك ستسقط في أول مهبٍّ للريح كوجود البيئة الحاضنة التي وجدتها الواصلات لأوربا فتهدَّمت بيوتٌ هي بالأساس من كرتون.


الأكثر شعبية


ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…

اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”



