الناس نيوز — هل الشر جزء من شخصية البشر أم يأتيها من الخارج؟ هل يحضر في التركيبة النفسية لكل إنسان؟ ومن أين يأتي الشرّ بحسب السرديات الدينية؟ هل يولد معنا؟ هل هو من يحركنا أم نحن من نحرّكه؟ وكيف تقارب الأديان السماوية الشرّ؟
الكاتب اللبناني رامي الأمين تناول هذا الموضوع في مقال له نشره في موقع درج اللبناني.
ويرى الباحث أنه في المسيحية، كما في اليهودية، يخبرنا العهد القديم عن الخطيئة الأولى لآدم وحواء في سفر “التكوين”، حيث خلق الله آدم وحواء في حالة البر والقداسة، أي على صورته الإلهية البارة المقدسة، ثم وضعهما في جنة عدن وأوصاهما أن يأكلا من شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر إذ قال لآدم “يوم تأكل منها موتاً تموت”، وعلى الرغم من ذلك، نجد أن الشيطان بهيئة أفعى يغري حواء فتأكل وتعطي زوجها أيضاً “فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضاً فأكل”(من سفر “التكوين”) وهكذا أخطأ آدم إذ عصى وصية الله وأكل من الشجرة وهكذا دخلت الخطيئة إلى العالم.
و بخطيئة آدم، أصبحت الخطيئة ميلاً طبيعياً في البشرية كلها، بحسب السردية المسيحية، وانتشرت في دمائهم فانزلقوا في الشر والإثم لهذا يقول بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميه: “ليس بار ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معاً”.
الشر والشيطان في الإسلام

في المقابل، يحضر الشرّ في أركان الإيمان بالديانة الإسلامية وهي ستة: “الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه”، فالقدر يحتمل الخير والشرّ، والمسلمون يبدأون تلاوة قرآنهم بعبارة “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم”، وبهذا يبدو أن الشرّ والشيطان حاضران في الدين الإسلامي بشكل متجذر، ويتقدم التعوذ منهما على البسملة في كثير من الأحيان، ولهما مكانتهما “الخطيرة” في تركيبة الإيمان الإسلامي، وهو ما يؤكده ورود كلمة الشرّ في القرآن الكريم مرات عديدة، وكذلك كلمة الشيطان، واسم ابليس. ويحضر الشرّ في القرآن بوصفه “امتحاناً”، وقد ورد في معوذتين تعوذان بالله “من شرّ ما خلق” (سورة الفلق) ومن “شر الوسواس الخناس” (سورة الناس). وعاقبة الشرّ الشرّ في الإسلام، وقد ينقلب الخير شراً: “وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”، والعكس بالعكس: “كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.
بول ريكو
وينطلق الفيلسوف الفرنسي بول ريكور، في كتابه “صراع التأويلات” من أحد “إعلانات الإيمان” لكنيسة الإصلاح، والذي فيه أن “إرادة الإنسان أسيرة تماماً للخطيئة” لمحاولة تأويل الشرّ وتفسيره، ويعتبر الإعلان أن “كل سلالة آدم قد تفشت فيها هذه العدوى والتي هي الخطيئة الأصل، ونزعة الشرّ موروثة”. هكذا يلخص الإيمان المسيحي الشرّ بنقطتين: خطيئة أصلية، ونزعة موروثة. ويخلص الإعلان في بنده الحادي عشر إلى أن نزعة الشر موجودة لدى الأطفال في بطون أمهاتهم!

ويستنتج الأمبن أن الخطيئة في المسيحية دخلت العالم مـن خلال إنسان واحد هـو آدم وبالتالي يصبح الإنسان لـيس هـو المصـدر الأول للشر في العالم، بل هو عبارة عن نقطة لظهور الشر في هذا العالم، ويرى ريكور أن ما ينقله رمز آدم في الكنيسة، “إن لم يكن الأصل المطلق فهو على الأقل نقطة انبثاق الشرّ في العالم. فلقد دخلت الخطيئة عن طريق إنسان واحد إلى العالم”.
الآباء اليونانيون واللاتينيون، كما يقول بول ريكور، يجمعون على ان ليس للشر طبيعة، وليس الشر شيئاً، ولا مادة، ولا جوهراً ولا عالماً، ولا يكون في ذاته، إنه “منا”. ويجمعون ايضاً على رفض السؤال نفسه عن ماهية الشرّ، أو “ما يكون الشرّ؟”، بل السؤال الأصحّ، هو: “من اين يأتي أننا نصنع الشر”؟ فالشرّ ليس “كان”، ولكنه “فعل”.
هذا التفسير للشر يقترب في شيء منه من تفسير الطباطبائي للشر كما يقدمه القرآن الكريم. فبالنسبة إلى الطباطبائي، الشر موجود وهو إرادي، يستطيع الانسان ان يختار بينه وبين الخير، وأعمال الإنسان تدل عليه، وإن فعل خيراً، خيراً يلقى، وإن فعل شراً، شراً يلقى. وبالتالي فإن الشرّ في الإسلام ليس مخلوقاً في الإنسان، كما هي الحال في المسيحية، والخطيئة ليست متوارثة ولا ترافق الطفل في بطن أمه، بل إن الخطيئة التي ارتكبها آدم جاءت بعدما وسوس له الشيطان ولزوجه، وكان الله قد حذره كما جاء في سورة طه “فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك”، ويقول الطباطبائي إن الشيطان كان يتراءى لآدم وحواء، فعرفاه وشاهداه، ولم يكن يوسوس لهما “مثلما يوسوس لنا بني آدم على نحو إلقاء الوسوسة في القلب من غير رؤية الشخص”. ويحسم الطباطبائي ان الشرّ ليس من صنع الله، فالله خير خالص، ولا مكان للشرّ في النظام العام الجاري في الكون، وهو أمر مختلف عن تعريف الشر “الأصلي” لدى اغسطين كما يشرحه ريكور، وهو ليس الخطايا التي نرتكبها، بل “حالة الخطيئة التي نعثر على أنفسنا موجودين فيها ولادة”.
فرويد
ولكن قبل ريكور بكثير، كتب فرويد في كتابه “قلق في الحضارة” أن السعادة مستحيلة، وقرّر أنه مهما تقدّم الإنسان وارتقى في مدارج الحضارة، فلن يكون قادرا على الوصول على السعادة. وبالنسبة لفرويد، الحضارة البشرية ليست سوى قشرة رقيقة تغلّف العواطف والشهوات والأنانية البشرية والرغبة في العنف.
وبحسب مقال للكاتب السوري وائل السواح، فإن هذه القشرة الرقيقة انكسرت عدة مرات في التاريخ، ولعلّ الحرب الكونية الأولى والحرب الكونية الثانية وجرائم النازية والستالينية والماوية. كلها تفجرّات أثبتت هشاشة البنية الحضارية للإنسان.
ثمّ مرّ حين من الدهر، ظنّ الإنسان فيه أن الأمور قد استتبت له، وأن نوعه قد سيطر على الطبيعة والحياة. فقد اكتشف الإنسان السلسلة الوراثية للجينوم البشري، ومحاولة تجاوز الاصطفاء الطبيعي الذي حكم التاريخ الطبيعي مليارات السنين، لإيجاد حياة جديدة قائمة على الذكاء الصناعي وليس الاصطفاء الطبيعي، وأطال متوسط العمر وحسّن في نوعية الغذاء، واخترع الأدوية الحديثة واللقاحات للأمراض التي كانت شائكة ومعقّدة وقاتلة، واكتشف أجراما سماوية تبعد ثلاثة آلاف ضعف المسافة بين الأرض والشمس، ثمّ أسقط جدار برلين وخلق نظاما سياسيا كونيا جديدا، وجاءت الموجة الثالثة من الديمقراطية لتحول بلدانا بأكملها من الأنظمة الشمولية إلى الديمقراطية. بشكل أو بآخر، سار الإنسان في طريقه إلى الخلود والسعاد المطلقة.
لا يرى مؤسس التحليل النفسي في الإنسان ذاك الكائن الطيب المتعاطف ذا القلب الذي يتوق إلى الحب. وهو لا يستخدم العنف فقط للدفاع عن نفسه، بل إنه يحمل في داخله دوافع عدوانية، وبواعث تدميرية. إنه يميل إلى إرضاء حاجته العدوانية على حساب أخيه، واستغلال عمل الآخر دونما تعويض، واستغلاله جنسيا من دون رضاه، والاستيلاء على أملاكه، وتحقيره وتعذيبه وقتله.
وما الحضارة بالنسبة له إلا غطاء يقمع الهوجان الفردي والرغائب الأكثر عدوانية، تماما كقشرة الأرض الرقيقة التي تغطي عمقا هائلا من المواد البركانية المتفجرة، التي ما أن تجد متنفسا لها حتى تثور في براكين لا تبقي ولا تذر.


الأكثر شعبية


ألكاراز يتغلب على روبليف ويواجه فيس في نهائي قطر المفتوحة…
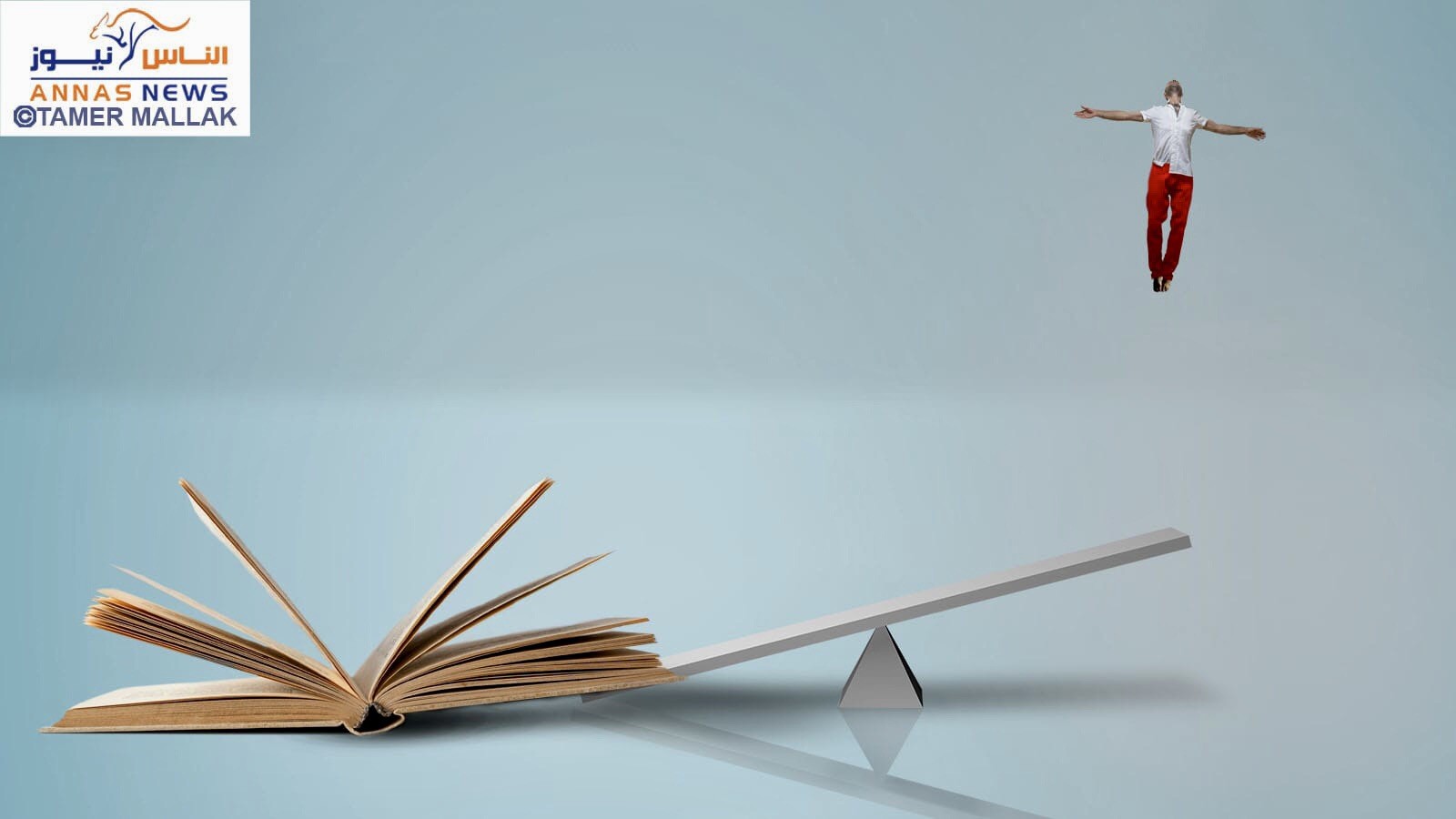
اليابان… حين تنتصر الدولة على “الغنيمة”



