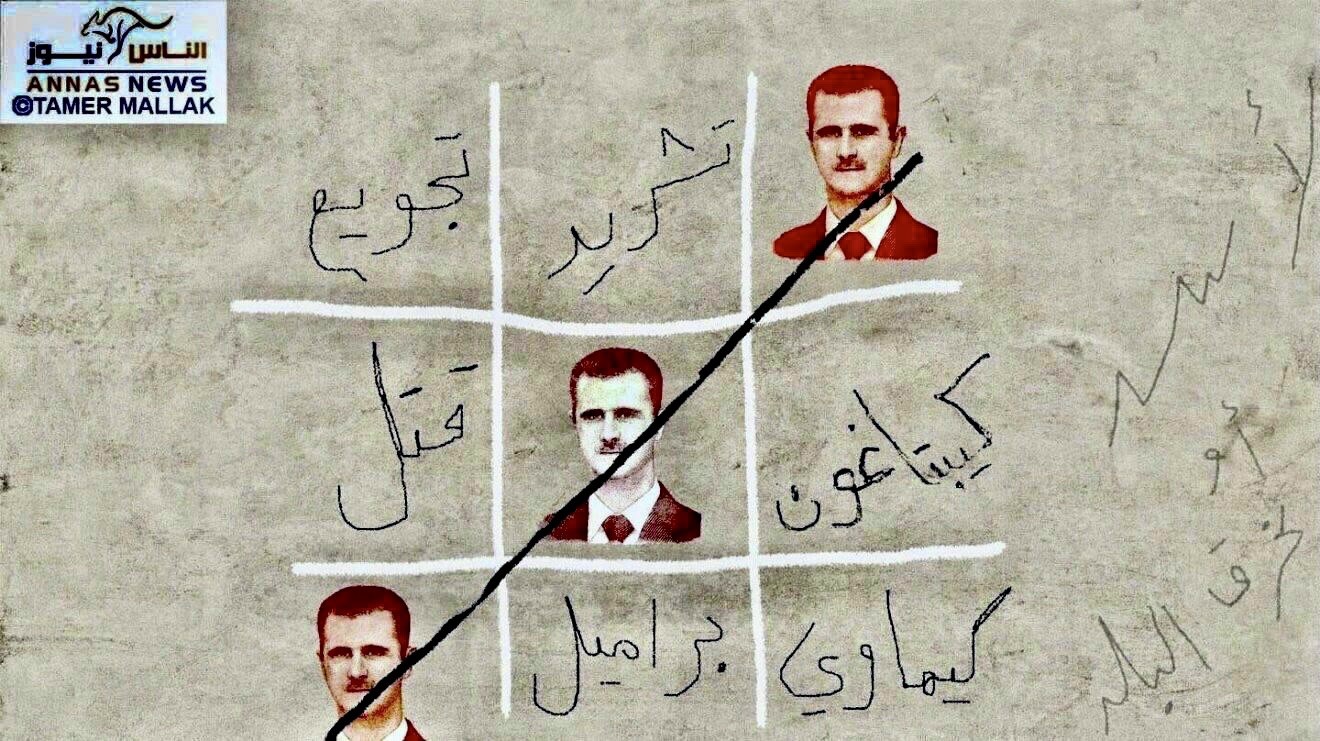عزيز تبسي – الناس نيوز :
قدم أول عرض سينمائي في مدينة حلب عام 1908، بمبادرة من مجموعة من مغامرين أوروبيين، وصلوا إليها قادمين من إسطنبول، حاملين معهم آلة متقنة تتحرك فيها الصور أفقياً.
عرضوا مجموعة من الصور المتحركة، في “مقهى الناعورة”، الواقع إلى جانب ناعورة “بستان الكتّاب”. نصبت بعد ذلك شاشة في “مقهى الشهبندر”، تبعتها أخرى في “باب الفرج”، وكانت كل الأفلام المعروضة صامتة.
عرضت الشرائط السينمائية في زمن لم تكن الكهرباء مستخدمة، وكانت عدسة الإسقاط، تستقبل الضوء من نور المصباح الغازي، بينما يدار قرص الفيلم باليد. مما يراكم هباب الفحم الناتج عن الاحتراق على العدسة الزجاجية، وحافزاً للجمهور في الصالة على إطلاق عبارة سجعية “امسح البلورة ياجوز العورة” التي ستختصر مع مرور السنوات إلى “البلورة ياجوز العورة”، واستمر تداولها، بعد تعميم الكهرباء على أحياء المدينة، وحلول آلات العرض السينمائي الحديثة، كتقليد احتجاجي على غباش الصورة.

لم تدرج بعد على ألسنة الناس عبارة “ماشا الله تمدنّا، وصار الضوء بالخيط والمي بالحيط” لأن هذا التمدن حصل في عهد الانتداب الفرنسي، الذي رخص لإنشاء شركة المياه
والكهرباء والترامواي. بعد أن أبرمت بلدية حلب في 17تشرين الأول عام 1924 اتفاقية مع المصرف العقاري الجزائري-الفرنسي، منحته فيها امتيازاً لاستثمار الكهرباء والحافلات الكهربائية. توزعت أغلب صالات السينما، في شارعي “بارون” و”القوتلي”، أبرز رموز الحداثة المعمارية والترفيهية أوائل القرن العشرين، حيث تمركز الرأسمال، المتجه استثمارياً نحو الترفيه والخدمات بإنشاء المقاهي والمطاعم والفنادق وعلب الليل وصالات السينما، واستقدام الفرق المسرحية والغنائية والراقصات.
توالت هذه المغامرة الفنية، بعد التحولات التاريخية التي وقعت في بلاد الشام، نهاية الحرب العالمية الأولى، وإخراج العثمانيين وحلول الانتدابين الفرنسي والبريطاني مكانهم، واقتسامهما الولايات العربية في المشرق العربي.
افتتحت في عام 1920سينما(الشرق)تحت فندق كلاريج أمام جامع “الملاخانة” وأغلقت عام 1925، كما افتتحت في العام ذاته سينما (باتا)فوق بناء أرضي، في المكان الذي يشغله
اليوم مطعم الأندلس أما سينما الكندي، وأغلقت عام 1928.
عكس الزمن القصير لافتتاح صالات السينما وإغلاقها، وهي بعمومها دكاكين ومقاهٍ جرى تجهيزها للعروض السينمائية، غياب شروط العرض السينمائي، ضعف الإقبال على عروض سينمائية أغلبها صامت، وما كان منها ناطقاً، كان بلغة أجنبية (معظمها بالفرنسية) لا يفهمها الناس، ضعف العائد الربحي. آثر الناس الإقبال على العروض المسرحية كما على الحفلات الغنائية الآتية من مصر ولبنان. منحازين إلى العالم الواقعي التفاعلي، على العالم الخيالي
الذي يتحرك بصمت في العتمة على الجدار الكلسي أو فوق قماش الخام. احتاج هذا الانتقال من اعتياد رؤية مشهد ثابت لأربعمئة عام إلى مشهد يتغير كل بضعة ثوان الى التأمل بالزمن المهدور، وتحفز للسيطرة على زمن آتٍ قد يلاقي المصير ذاته.

تحولت عام 1925(سينما شرقي الناطقة) التي كانت مسرح “أورينتال” إلى صالة سينمائية، وكان لها مقصورات خاصة بالعائلات، وشرفات دائرية، وسجل التاريخ السينمائي لها، عرضها لأول فيلم بالألوان الطبيعية. استمرت في عروضها السينمائية متكيفة مع التحولات التي أعاقت الإقبال على العروض السينمائية، منتقلة من صالة حظيت باحترام التقاليد العائلية ،حيث
خصصت مقصورات مستقلة ومميزة ،للعائلات التي بدأت تواكب هذا الفن الحديث، انتقلت بعد نصف قرن من الوعد التحديثي بأفقه التحرري إلى عرض أفلام الكاراتيه، وبغفلة انتقلت إلى ما عرف بالعرض المتواصل، حيث يدفع الزبون أجرة حضور فيلم واحد، ليحضر ما تعرضه صالة السينما من أفلام، وهي بالعموم ثلاثة أفلام، ولعدد غير محدود من المرات حتى تحين ساعة إقفالها،
وكأنها عودة للزمن الذي يهدر…تزامن هذا التحول مع تحولات شملت معظم صالات السينما في المدينة، ليغدو معظمها مرتعاً للعاطلين العمل، العساكر الذين من خارج المدينة الذين يقضون يوم عطلتهم ، للشاذين جنسياً ، للمراهقين الفارين مدارسهم. واستمرت تتحايل على قدرها، حتى عام 1988 ، لتتحول إلى صالة للأعراس لبضعة سنوات، قبل أن يقرر أصحابها إغلاقها نهائياً. شيدت الأبنية المخصصة كصالات سينما وتوزعت في شارع فرنسا (شارع القوتلي بعد الاستقلال) صالات سينما رويال – ليلى-ديانا..
وتوسعت إلى باب الفرج سينما “الشرقي الناطق – غازي-القاهرة – وإلى بستان كل آب سينما فاروق .. وإلى جوار باب النصر سينما السعد – فيصل.
وفي الجهة الغربية لنهر قويق سينما دنيا (جوار منتزه الأزبكية) وسينما فريال (باتجاه الجميلية) سينما الفردوس في شارع اسكندرون…وسينما الجمهورية بمقابل لونابارك (وسط ساحة سعد الله الجابري).. إحدى وعشرون صالة للسينما، برزت فيها أفلام الأخوين الفلسطينيين “بدر وإبراهيم الأعمى، الذي انقلب لقبهما بعد هجرة عائلتهما إلى أمريكا اللاتينية الى “لاما”، وسيتبعهما المخرج التشيلي الفلسطيني الأصل ميخائيل يتيم إلى ميغيل ليتين، كما قلب الاحتلال الصهيوني أسماء القرى الفلسطينية وبلداتها.

رحبت الصالات بالناس، ولم تسع لاستفزاز وعيهم الموروث، وبقيت رابضة على تخوم حداثة خنوعة مرتبطة بالتجارة والتربح. دعا مالك سينما أمبير في عام 1939 مفتي المدينة “محمد الحكيم” لحضور افتتاح فيلم عن مناسك الحج، وهي من الصالات التي أُنشئت وفق مخطط هندسي خاص بالعروض السينمائية، وحازت على موقع مميز على الزاوية المطلة على شارعي القوتلي والبارون، لتشجيع الجماهير الإسلامية على ارتياد السينما.
سعى أصحابها لإرضاء أمزجة الجمهور، بأفلام غنائية صدحت فيها أصوات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان وليلى مراد. وأفلام البطولات الخارقة لقتلة ومغامرين من رعاة البقر وطرزان وشخصيات مأخوذة من الأساطير الإغريقية، إذ تنفر الشعوب المضطهدة من رؤية الاضطهاد والانكسار، وتبحث دوماً عن انتصارات تداوي انكساراتها، وأغانٍ تسكّن أوجاعها. أحضروا أبطال الأفلام من مصر ولبنان ليفتتحوا العروض الأولى لأفلامهم.
ظلوا يدخلون من بواباتها الواسعة، ويخرجون من منفذ النجاة الضيق، كأنما يفرون من حريق داهمها، أو يتربص بها ليجهز عليها حين غرة. تاركين بعمقها، المشاهد التي تابعوها بمتعة والحوارات التي أصغوا إليها بشغف. يعبرون الى أضواء الشارع: ليبقى ما رأوه وسمعوه
خلف باب الحديد، الذي يتهيأ الحارس لإغلاقه وإرتاج مغاليقه.
أَنشأت وزارة الثقافة والإرشاد القومي سينما للأرياف، كلفت بها سيارات مغلقة تدور على القرى، لتعرض عليهم أفلاماً عن الثورة الجزائرية والفلسطينية وأخرى عن الزراعة والأسرة، وأسس بدوره الاتحاد الوطني لطلبة سوريا نوادي سينمائية في جامعتي دمشق وحلب.
تجارب عبرت عن الآمال التحريرية الحالمة التي لما تزل تجيش بصدور مثقفين شاركوا العسكريين في الحكم، مراهنين على صيغة “حرق المراحل” ودور الجيش في التغيير الثوري.
توقفت تجربة السينما الجوالة وتبعتها بعد سنوات النوادي السينمائية في الجامعة والمراكز الثقافية، التي تأسست بمبادرات من شبان يساريين، أرادوا تعويض تحالف حزبهم مع السلطة ، بعبارات نارية حلقت خارج الزمان، أكملوها بتحليق خارج المكان، باستهلاليات غنائية تسبق نقاش الفيلم عن ثورات تستنبت بالأدغال الأفريقية وجبال أمريكا اللاتينية ووهاد آسيا، ولا تستقر مواكبها بهذه الأرض إلا بعروض سينمائية، يعيق مناقشوها صليل أساور الحديد، وتنتهي بخروج مرهق ودعوات بالهمس لاستكمال النقاش في البيوت.
لم تضع منهم أفلام “حلاق سيبريا ” و “فورست كامب” و “الحياة كمعجزة” و “مدينة الله” و “بارييا” و”يد إلهية”، و”غابة” و”الممثلون الجوالون” و”رسائل البحر”، و”باب الشمس” فحسب، وإنما الحداثة بعمقها الديمقراطي والعقلاني والتحرري، الذي يمدها ويشد جذعها بنسغ البقاء.

السينما ليست الحداثة الموعودة، لكنها جزء منها كما المسرح والصحافة والنقابات العمالية والتنظيم السياسي والحياة الديمقراطية ، والتفكير المتحرر من الرقابة المسلحة، التي تتوعد بالقتل والسجن. تحققت وتكرست حداثة التبعية، خارج الرومانسية الوطنية وآمالها الكبيرة، بفك روابطها مع العثمانيين وإعادة ربطها بالمركزين الرأسماليين بريطانيا وفرنسا، المركزين
اللذين قلصت توسعهما ونهبهما وعدوانيتهما نتائج الحرب العالمية الثانية، التي نقلت مهامهما إلى المنتصر الأمريكي، الذي متن الأنظمة التي تحرس التبعية، وأحيا أيديولوجيا القرون الوسطى، بحرب على الكفار.
بقيت نبتة غريبة عن ثقافتنا وهويتنا وتقاليدنا، لم تحظَ باهتمام البندورة والبطاطا والذرة الصفراء والتبغ وعشرات التوابل والورود والطيور وقائمة طويلة تكاد تكون بلانهاية، لم نكن لنتعرف عليها قبل اكتشاف القارة الأمريكية. كأنه قدر الكائنات المستضعفة التي لم تتوطن في الأرض ولم يُعتنَ بها. أهينت وسخر منها.أقصيت جانباً، لتذروها الريح بلا رحمة.
عزيز تبسي حلب أيلول 2020