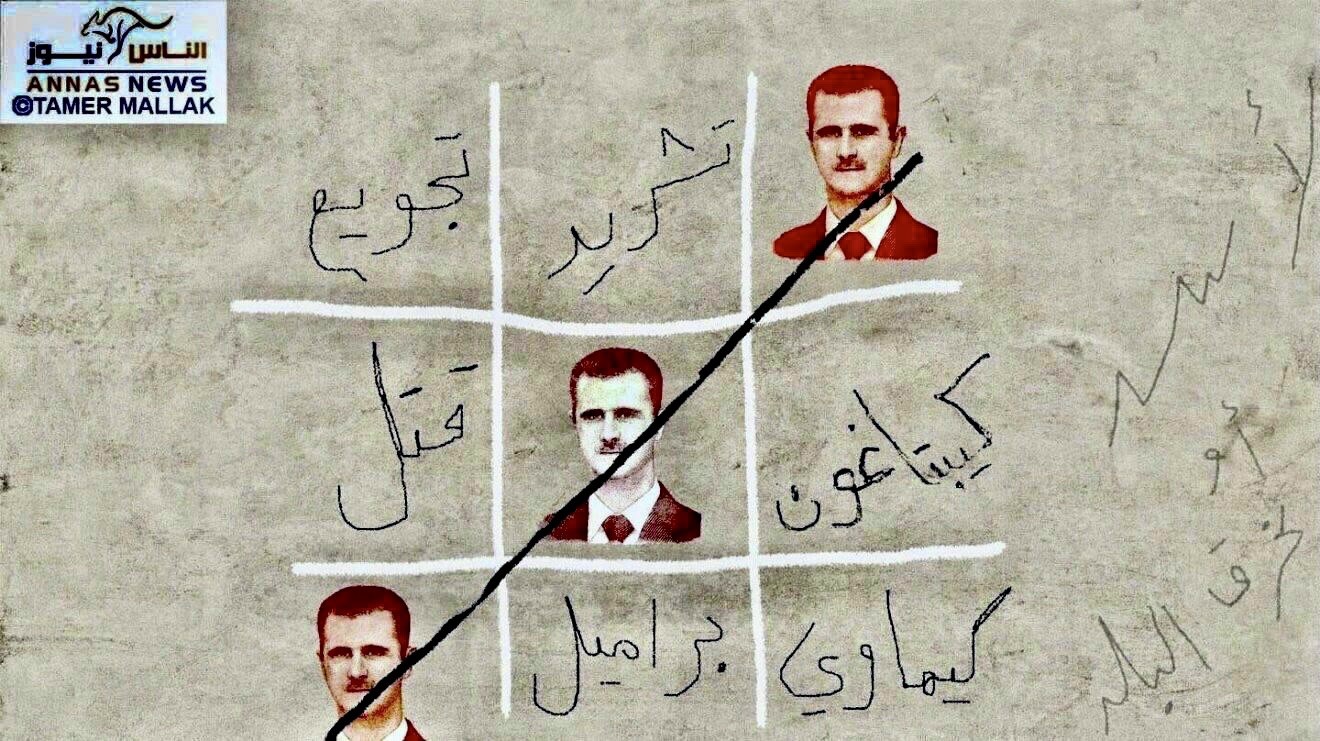علي عبد الله – الناس نيوز :
الفن هو أول وسيلة في حياة الإنسان تتحول إلى غاية، حيث بدأت البشرية بالمحاكاة التي أصبحت رفيقة الإنسان في فهم أسرار الكون ومفاتيحه.
إن تقليد الطبيعة أو محاكاتها، كان أول فعل مارسه الإنسان تعبيراً عن رغباته وهواجسه ومخاوفه من جبروت الطبيعة ومخلوقاتها الأسطورية، وبذلك استطاع هذا الكائن البدائي التعرف على الطريقة المثلى في التعامل مع الضغوط النفسية ومعالجتها.
وكان الصوت أولاً، إذ بدأت المحاكاة للطبيعة من خلال أصواتها ومؤثراتها التي زرعت في داخل الكائنات الحية الكثير من القلق الذي لم يجد له إنسان العصر تفسيراً أو تحليلاً لأسبابه ومسبباته.
بهذه المواجهة الفطرية المتفردة استطاع الإنسان أن يبدد القلق ويحوله إلى اشكال صوتية ومؤشرات يستعين بها، عند الحاجة، بوصفها أولى دلالات اللغة الصوتية بعد لغة الإشارة وإيماءاتها.
من هذا السياق استدل الإنسان البدائي على احتياجاته الحياتية الأخرى، إذ أصبح مفهوم المحاكاة هو الحافز في تناول كل أشكال الطبيعة سعياً لتأسيس حياة يسودها نوع من الفن وتأثيراته.
ووفق هذا المفهوم أصبح مصطلح فن المحاكاة عنواناً لمسيرة الإنسان وتطلعاته التي وثقتها الفلسفة وأسهبت في مفهومها ودورها في الحياة وتطورها، وكان للفيلسوف( أرسطو ) الجانب الأكثر إشراقاً وتحليلاً لماهية المحاكاة وأصولها؛ مخصصاً لهذا المصطلح جانباً كبيراً ومهماً في فلسفة الفن والجمال وتفسيراتها.
توطدت العلاقة بين الفن والطبيعة وعلاقة الإنسان بينهما، وتطورت تلك العلاقة مع تطور طموحات الإنسان ومدركاته؛ متدرجاً من التعبير النفسي للأشكال ومدلولاتها، متجهاً نحو تلبية حاجة الذات إلى الجمال في تزيين الحياة وواقعها، بعد أن أصبح لذلك الإنسان مقرٌ ثابت ووظيفة حياتية تنسجم مع طبيعة التجمعات التي أفرزتها المرحلة التاريخية وبما تتطلبه طبيعة حياته واستقرارها.
أسهم التعبير في الرسم والنحت والفخار والخزف والنقش عن مكنونات الجمال في رسوم المناظر الطبيعية، وفن ال( Portrait ), والمجسمات والجداريات وما جادت به ذائقة الفنانين، فكانت واجهات المباني وجدرانها تزدان باللوحات والمجسمات التي غدت دلالة على تاريخ مسيرة الشعوب ومقياساً لمدى تحضرها.
إن ظهور الكاميرا الضوئية في النصف الأول من القرن التاسع عشر أصبح الحد الفاصل بين مرحلة الفن التاريخية، وشكلت انطلاقة واسعة نحو نشأة مدارس الفن وانتشارها، التي أختلفت كثيراً وبعيداً عن طبيعة الفن التقليدي وممارسته.
فمع ابتكار الفرنسي( Louis Daguerre) وزميله في عام 1839 لتلك الكاميرا التي كانت مفاجأة كبرى للعالم، إذ سمحت بتسجيل اللقطة الحياتية وتوثيقها، مستجيبة لرغبات الإنسان وطموحاته في تطوير تلك التقنية، فيما بعد، إلى فن التصوير ( Photography )، بوصفه فناً مستقلاً له أصوله وتقنياته.
كان لهذا الفن الجديد تأثيره الكبير على طبيعة الحياة الثقافية وتطورها، إذ استعاضت ذائقة الأغلبية في تصوير الطبيعة بديلاً عن نقلها بريشة أو إزميل فنان، وفسحت بذلك المجال لآراء النقاد والمهتمين بالغور عميقاً عن جدلية العلاقة بين الصورة واللوحة والمجسم، فكان التساؤل الأهم: هل الصورة أجمل، أم اللوحة؟، وربما بشكل أدق، ما الذي يمكن أن يضيفه الفنان إلى جمال الطبيعة ومميزاتها؟.
لقد كان ظهور المدارس الفنية المتنوعة: الانطباعية، المستقبلية، التعبيرية، التجريدية، السريالية، الدادائية، التكعيبية، وغيرها، تلك المدارس التي نشأت ترجمة للتساؤلات السابقة ، وغيرها، وتعبيراً عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الفن وعلاقته بالواقع وأشكاله، فكان جل ما يشغل النقاد والفنانين والمفكرين( الذين عابوا على الفنان تمسكه بالتقليد الحرفي)، كيف يستجيب الفن للفكر الإنساني الذي تفجرت أمامه قدرات وأحداث مهولة من الأفكار المتحررة، وما أفرزته نتائج الثورة الصناعية، والابتكارات المتلاحقة ، فضلاً عن التكنولوجيا والأحداث الجسام التي صادفها إنسان العصر.
كيف يمكن تقييم الفن وهو ينقل الواقع كما هو كائن، في حين يجدر بالفن أن يقوّم الواقع وينهض به إلى رؤى الفنان/ الخلاق وفكره ومهاراته التي يتميز بها عن باقي شرائح المجتمع وأحاسيسهم وتطلعاتهم التقليدية وبديهياتها.
إن خاصية الفن بعدم التزامه بالمسلمات وكسره للتقليد، وبحثه الدؤوب عن الاستثناءات، وفسحته في ما وراء الطبيعة وتجلياتها؛ هو الحافز الذي أتاح للعلم والابتكار والاختراع أن يسهم في زخم الحياة المعاصرة وتقدمها.
يتبع
- لن نتطرق إلى تاريخ التصوير الضوئي، الذي يسرد فيه البعض وفق تفاصيل تعود به إلى أزمنة بعيدة جداً، لذا تم التركيز في مقالنا على مضمون البحث وآثاره .