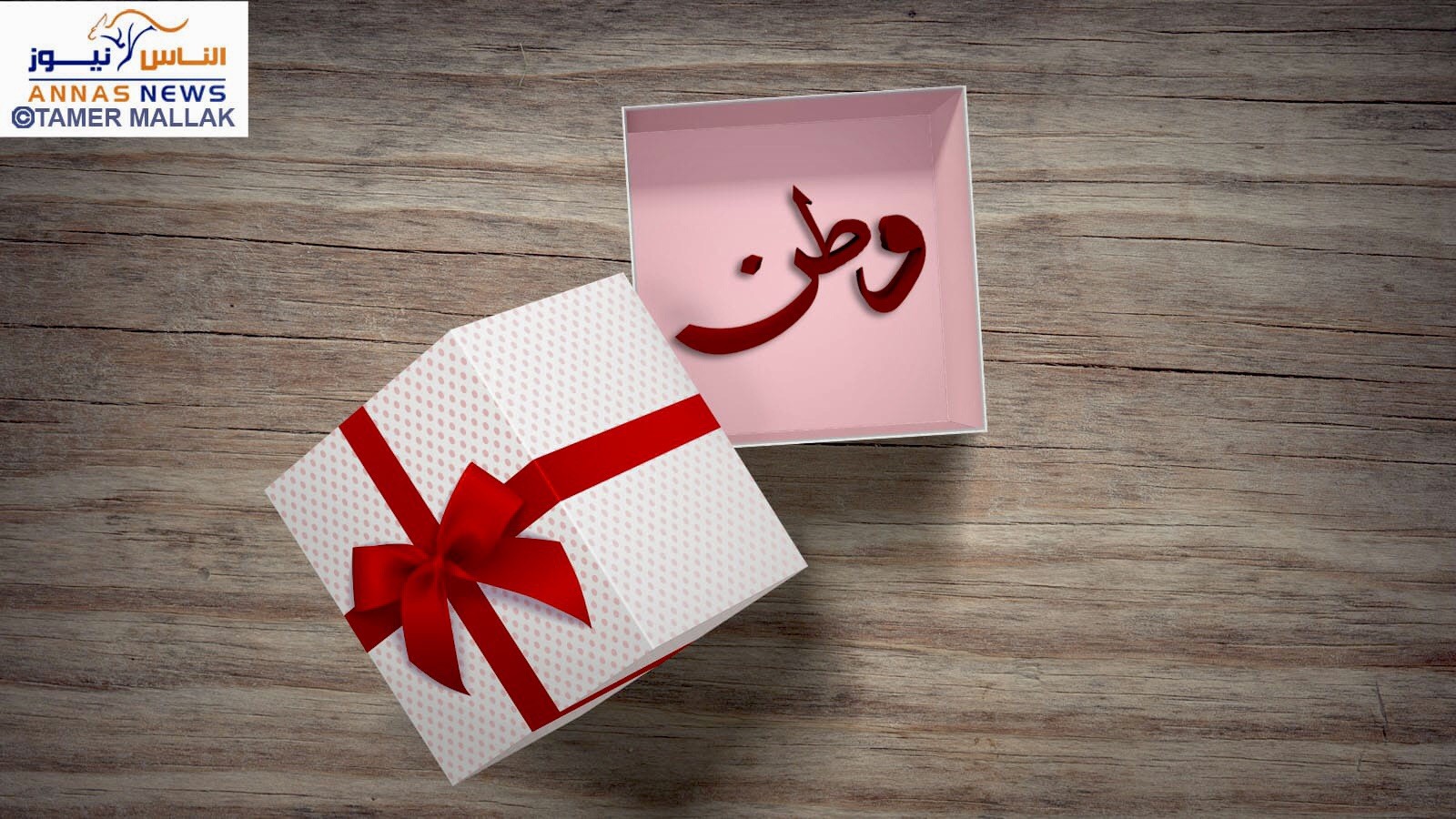أحمد عزيز الحسين – الناس نيوز ::
شكّلت الحربُ متناً حكائيّاً موّاراً لإرْثِ الإنسانيّة المكتوب، بدءاً من (الإلياذة) لـ(هوميروس)، ومروراً بـ (الحرب والسّلام) لـ(تولستوي) و(وداعاً أيها السّلاح) لـ(هيمنجواي)، و(الدّون الهادئ) لـ (شولوخوف)، و(أفول القمر) لـ ( شتاينبك)، و(الحريّة والموت) لـ (كازانتزاكس) و(جسر على نهر الدّرينا) لـ ( إيفو أندرتش)، و(زقاق المدقّ) و(خان الخليلي) لـ ( نجيب محفوظ)، و(الحرب في برّ مصر) لـ ( يوسف القعيد)…. الخ، ووصولا إلى النّصوص الرّوائية العديدة التي تمخّضت عن الحرب السّوريّة، وبلغت عدّة مئات، ونافَ عددُ الذين كتبوها على مئتي كاتب، وقد أمسى بين يدي المتلقّي السّوريّ والعربيّ بفضل هذه الفورة السّرديّة نصوصٌ روائيّةٌ متفاوتةُ المستوى، أولى بعضُها المشهدَ الخارجيَّ للحرب جُلَّ اهتمامه، فرصَد أحداثَها، وتقصّى وقائعَها، ولاحق صانعيها، في حين أماط في بعضها الآخر اللِّثامَ عن الجروح المُدَمّاة والنّدوب العميقة التي تركتْها هذه الحربُ في نفوس النّاس وقلوبهم معاً، ومن هذه الرّوايات التي برعت في الكشْفِ عن هذه النُّدوب (الفناءُ الخلفيّ) للأديبة السّوريّة (لميس الزّين) الصّادرة عن (دار رياض الرّيّس في بيروت) ( فبراير/شباط -2022).
الحرب بوصفها حيلةَ سرديّة
ولميس الزّين لا ترصد بعضَ وقائع الحرب السُّوريّة من موقع الكاتبة الرّاغبة في البحث عن الحقيقة، ولا تجعل منها محورَ اهتمامها بوصفِها حدثاً له أبطالُه ووثائقُه ويوميّاتُه، بل تُدِير ظهرَها إلى هذه الوقائع من موقع الكاتبة الرّاغبة في التّوثيق، وتجعل حديثَها عنها أداةً فنيّة، وحيلةً سرديّة بغية مواجهة البنية الاجتماعيّة التي كانت تثوي في مدينتها الرّوائيّة المُتخيَّلة (حلب)، ولهذا فالحربُ ليستْ هدفاً لخطابها الرّوائيّ، بل هي أداةٌ استثمرتْها لتشريح البنية الاجتماعيّة البطركيّة، وكشْفِ الهاجع والثّاوي والمسكوت عنه في مدينتها، ولذلك غدتِ الحربُ شرارةً وظّفتْها لإضرام النّار، وتحريك الرّاكد في هذه المدينة، وجعلتْها تطفو على السّطح، بعد أن كانت هاجعةً منذ مئات السِّنين، وما ذُكِر من عبارات تشير إلى (النّظام) و(المسلَّحين) أو (حلب الشّرقيّة) أو(حلب الغربيّة) ليس سوى عناصر سرديّة اقتضَتْها صياغةُّ المتن الحكائيّ، وتكشُّفُ حلقاته السّرديّة، وتشكيلُ السّيرورة الجماليّة التي لاحقتْ تناميَ المتْنِ، وحركةَ الشّخصيّات في الفضاء الرّوائيّ، وهي تُواجِه بعضَها بعضاً، أو تتلقّى عقابيلَ الحرب التي اندلعتْ في مدينتها المُتخيَّلة، وأفضى بها إلى كشْفِ النّقاب عمّا كان يفور ويضطّرب في أعماقها الدّفينة.
بنية التّوازي
تنهض (الفناءُ الخلفيّ) على إقامة توازٍ بين تشظّي وطنٍ ومدينةٍ، وتمزُّق أسرة، مع ما يستدعيه ذلك من انعكاس على حياة شرائح متعدِّدة، منها التّاجر، والمثقَّف، والمحامي، والموظَّف، والطّالب الجامعيّ، والإنسان العاديّ (رجلا كان أم امرأة أم طفلا). وقد لاحقت الرّوايةُ تشظِّي المدينة والوطن من خلال رصْدِ الصّراع الدّامي بين (النّظام) و( المسلّحين)، كما لاحقتِ التّفكُّكَ الذي آلت إليه أسرةُ (الحاجّ قدري) (بوصفها نموذجاً للتّاجر الحلبيّ) من خلال متابعة التحلُّل الاجتماعيّ والانهيار الاقتصاديّ الذي أصابها، وقد أثبتت الرّواية أنّ هذه الأسرة كانت متحلّلةً من الدّاخل، وغير قادرة على مواكبة الحياة المتجدِّدة، وأنّ قوّتها وصلابتها الظّاهريّة التي كانت تحتكم إليها لم تكن سوى قشرة خارجيّة هشّة، لم تستطع الصُّمود في مواجهتها للتّغيُّرات الدّراماتيكيّة التي أصابت المدينة في ظلّ الحرب.

وقد تقصّت الرّوايةُ ما أصاب الأسرةَ من تحوُّلات عميقة مزّقت الشّرنقةَ التي كانت تتخفّى وراءها، ولاحقت كيف أمست الأيديولوجيا السّلفيّة المتزمِّتة جداراً يحول بينها وبين الحياة، ويجعل مثلها الأعلى كامناً في ماضٍ غبَر لا يمكن استعادتُه، ما جعل (سامي) أصغر أبنائها يتمرّد عليها، ويرفض التّقيّد بما تُملِيه عليه من نمط حياةٍ يحول بينه وبين تحقيق ذاته على الوجه الأمثل، ولذا ينخرط في المظاهرات التي تجري في الخارج بغية كسر طوق الخوف والطّاعة الذي انصاع له مرغماً منذ طفولته، كما أنّه يُقدِم على الزّواج من فتاة أكبر منه سنّاً بحثاً عن ذاته المُستلبَة، وسعياً للخلاص ممّا هو فيه، كما أنّ نمطَ الحياة المعطوب نفسَه أفضى بأخيه (أنس) للانضمام إلى (المسلَّحين) بعد أن دُمِّر جسدياً، وسُحِق نفسيّاً، ولم يستطع البوح باسم الشّخص الذي اعتدى عليه، وهو صغير، خوفاً من العار الذي يمكن أن يلحق به في أسرته المتزمّتة، فأفضى ذلك كلُّه إلى مقتله، أمّا أخوه (حمزة) فيمّم وجهه شطر تركيّا باحثاً عن حياة جديدة حاملا معه كلّ ماجنَتْهُ الأسرة من مال، فاشترى أرضاً لبناء مصنع جديد، وقام بتسجيل الأرض باسمه، زاعماً أنّ المال الذي اشتُرِيتْ به الأرضُ تمّ بجهوده هو، ومن حقّه أن يستولي عليه دون بقيّة إخوته، وهكذا أثبت أنّ ما كان يتظاهر به من ادّعاء وحرص على الدّين والقيم والأخلاق ليس سوى “تقوى شكليّة” لم تمسَّ سلوكه الحياتيّ، أو تنفذ إلى أعماقه وقلبه، بل ظلّت مجرّد شعار أيديولوجيّ صرف كان يرفعه لنيل رضى والديه، أواكتساب إعجاب الآخرين، بدليل أنّه تخلّى عما تُفضِي إليه هذه الشّعائر من حرص على العدل والمساوة في أوّل اختبار اقتصاديّ استُخدِم محكّاً لقيمه.
وفي الإطار نفسه تقصّت الرّواية ما أصاب شخصيّتها المحوريّة (شمس) من عطب وأذى نفسيّ بسبب نشأتها في أسرة بطركيّة هي الأخرى، فقدّمت لنا نُتفاً من حياتها، وكيف كانت مقموعةً في أسرة يهيمن عليها الأخ الأكبر، ولا يُبِيح لها أن تفعل ما تريد بذريعة أنّها “بنت”، وأنّ تصرُّفها قد يسيء إلى سمعتها أو سمعة العائلة، وعاشت بين “أخوين لا يعوزهما التّسلُّط، وأمّ أقصى أمنياتها أن تراها مستورةً في بيت زوج”(ص28)، وكانت تلجأ إلى الصمت بوصفه وسيلةً لمقاومة ضغوط المجتمع البطركيّ عليها، وقد حرص هذا المجتمع على أن يجعل منها نسخة طبق الأصل من مثيلاتها، غير مؤمن باختلافها عنهنّ،وهكذا لم يُتَحْ لـها أن تعيش مراهقتَها كبنات جيلها، وحُرِمَتْ من الاستمتاع بطفولتها، وقُمِعتْ تصرُّفاتُها التي تتشبّه فيها بالذُّكور، ومُنِعت من اللّعب معهم بذريعة أنّ البنت التي تلعب مع الصّبيان تصير صّبياً. وقد جعلها هذا المنعُ تنكفئ على نفسها، وتُمسِي حبيسةَ عالمها الصّامت، إذ لم تستطع مسايرة أفانين المجاملات الاجتماعيّة التي تنهض على النّفاق والازدواجيّة، كما أنّ النّاس من حولها لم يتفهّموا اختلافها الكبير عنهم بسبب افتقارهم إلى المرونة والاستنارة، وهكذا حُكِم عليها بأن تعيش معزولةً عن زميلاتها وزملائها في الجامعة، ولم تفلح في إقامة علاقات ناجحة مع كلا الجنسين، وترك ذلك كلُّه تأثيره الكبير في حياتها الاجتماعية والعاطفيّة، وقد فاقم من عزلتها سفرُ أخويها إلى خارج البلاد، فأمست وحيدةً بعد أن تركتْها عمّتُها سعاد، والتحقت بابنها في الطّرف القصيّ من المدينة خوفاً من الخطر والموت.
ولم تنجح علاقتُها (الافتراضيّة) مع الشّاعر الرّهيف يوسف بسبب بحثها الدّائب عن الحبّ المثاليّ، واختلافها معه حول مفهوم الحبّ نفسه، وهل يجمع بين الرّوح والجسد أم يقتصر على الجسد وحده، ومع ذلك قرّرت المخاطرة بالعبور إلى (حلب الشّرقيّة) للقائه، لكنّ يوسف اعتذر عن الزّواج منها حرصاً على سمعته بوصفه متزوّجاً من امرأة أخرى، وعرض عليها بأن يبقى حبُّهما عذريّاً، فرفضت ذلك مُسوِّغةً موقفَها بأنّه “لاحبّ من دون جنس”، وأنهى العلاقة بينهما توقُّفُ وصول أخبار يوسف إليها بسبب تفاقُم حدّة الاشتباكات بين الأطراف المتصارعة، وسقوط قذيفة على منزله أفضت إلى مقتله مع أسرته.
وحين تعرّفت شمس إلى (سامي) بعد إخفاق علاقتها مع (يوسف) وافقت على الزّواج منه بعد تلكّؤ، حرصاً على إرضاء حاجتها الجنسيّة تحت مظلة الشّرع، ولأنّها كانت ترى أنّ حاجة المرأة إلى الرّجل قد نُظِّمت بعقود ارتقت بها “إلى علاقة واعية بين رجل وامرأة، وليس علاقة غريزيّة حيوانيّة فقط”، ولذا آثرت القبول بعرضه بعد أن تبيّن لها أنّ العلاقة غير الشّرعيّة التي كانت تقوم بين صديقتها (ناهد) وبين (الأستاذ جلال) لم تستطع إشباع هذه الحاجة، ولذا آثرت الاكتفاء بما هو مُتاحٌ بين يديها، واكتشفت بعد زواجها من (سامي) أنّه زوجٌ محبّ ومُتفهِمٌّ، وقد واجه معارضة أهله لكي ينجح زواجُه منها، لكنّ توتُّر الأوضاع في مدينتها حال دون استمرار الزّواج، إذ اضطّرَّ سامي إلى الهجرة تحت ضغوط الحاجة والرّغبة في حياة آمنة ومستقرّة، وتركها وحيدةً، ولم تشأ اللّحاق به، لأنّها كانت تعتقد بأنّ زواجهما لايستند إلى أسس متينة تضمن له الاستمرار والنّجاح، وهكذا أرسلت، في خاتمة الرّواية، رسالة اعتذار إليه تخبره فيها بأنّ لكلّ منهما طريقاً مختلفاً عن الآخر، وأنّ إمكانية استمرار العلاقة بينهما غير ممكنة، وأنّها كشجرة السّرو لا تستطيع أن تهاجر، لأنّ جذورها ضاربة في الأرض، وعليه أن يبحث عن امرأة أخرى لإكمال حياته، وأنّه” قادرٌ على خلق الجمال أنّى حلّ” (ص235).
سرديّة الجسد
تُقارِب الرّواية، في بحثها الحثيث عن سرّ شخصيّاتها المأزومة، (ثيمة الجسد)، وتَعُدُّ الحديثَ عنها استكمالا لحديثها عن أزمة الشّخصيّات نفسها، ولابدّ قبل مقاربة هذه (الثِّيمة)، من الإشارة إلى أنّ صورة الجسد، أو هيئته، معيارٌ يُقيَّم به الشّخصُ نفسُه، ويُحكَم عليه حكماً معيَّناً في ضوء هذا المعيار، مع الأخذ في الحسبان علاقة الشّخص بالعالم الذي يعيش فيه، وهذه القيمة ناتجة عن تأثير السّياق الذي يندرج فيه الإنسانُ نفسُه، وليست معطًى موضوعيّاً مستقلّا عنه، وغالباً ما يصبح ميلُ الإنسان إلى الاستمتاع بجسده من الأفعال المرذولة والمُستقبَحة في المجتمع البطركيّ أوالسّلفيّ.
و تعرض الرّواية رؤية (الحاجّ قدري) وأسرته لهذه (الثّيمة) بوصفها اختزالا نموذجيّاً لرؤية الأسرة السّلفيّة بشكل عامّ، فتؤكّد أنّ هذه الأسرة تفصل بين الإنسان وجسده، وتنظر إلى الجسد الإنسانيّ على أنّه مُحتقَر ومرذول، وتُطالِب بإلغائه ومحْوِه، وتعدُّ الاهتمامَ بالجسد والتّمركزَ حوله عيباً ينبغي على المسلم ألّا يقع فيه، وهي ترى أنّ المرأة المثاليّة لا تستطيع تحقيق ذاتها بشكل مثاليّ إلا إذا غيّبَتْ وجهَها، وألغت اسمَها، بل إنّها تذهب أبعد من ذلك حين تمنع الاحتكاكَ الجسديَّ مع الآخر، ولا تُجِيز للأخ أن يُقبّل أخاه إلا إذا كان مريضاً أو عائداً من سفر، كما أنّها تُبِيْح لنفسها الهيمنة على جسد المرأة، وتمنعها من الاهتمام به (كما فعل أخوا شمس، وأمّ ناهد بهما)، ولذلك لا يرتبط تحقيق الذّات عندها بامتلاك الجسد، بل يرتبط بالتّعالي عليه، وتغييبه، والتّسامي فوقه.
إنّ صورة الجسد أو هيئته معيارٌ يُقيَّم به الشّخصُ نفسُه، ويُحكَم عليه حكماً معيَّناً له علاقة بالسّياق الذي يتعالق معه، وهذه القيمة ناتجةٌ عن تأثُّر الشّخص بهذا السّياق، وليست معطى موضوعيًّا مستقلّا عنه. ومعلوم أنّ (الوجه) هو الجزء الأكثر فرديّة وخصوصيّة في الجسد الإنسانيّ، بل هو رمزٌ لتميُّز الإنسان من غيره، ودليلٌ على تفرُّده، فإنْ مُحِيَ وغُيِّب فقد مُحِيتْ ذاتُه وغُيِّبتْ، كما أنّ حجْبَه ليس سوى حجْبٍ لماهيّة الإنسان وجوهره، ويستوجب تغييبُه منعَ حاسّة البصر من الوقوع على امرأة، لئلّا يُفضِي ذلك إلى الوقوع في المعصية، فالمسلم الحقّ، في رأي أسرة الحاجّ قدري، هو الذي يُواري عينيه عن النّظر إلى المرأة حتّى لو كانت قريبة له، مع أن ديكارت عدَّ (حاسة البصر) أكثر حواسّ الإنسان شمولا ونُبْلا.
لقد جُعِل الجسَدُ منفصلًا عن الإنسان، وغريباً عنه من وجهة نظر الدّين والفلسفة الأفلاطونيّة، ونُظِر إليه، في الفلسفة الدّيكارتيّة، على أنّه جهاز آليٌّ تحرّكه الرُّوح، كما أنّ الفلسفة الدّيكارتيّة أقامت انزياحاً بين الشّخص وجسده، بحيث أمسى الجسدُ فيها تابعاً للشّخص، وليس علامةً على تفرُّده، كما اعتُبِر إهمالُ حاجة الجسد إلى (الجنس)، والتّسامي فوقها دليلا على التّديُّن وبلوغ درجة مثاليّة من الزّهد والتّقوى، ونُظِر إلى ميل الشّابّ أو الفتاة إلى إشباع حاجتهما الجنسية على أنه خروجٌ على الدّين والأعراف الاجتماعيّة المُستحَبَّة، وأمسى الشّخص المثاليّ هو الذي يتعالى فوق حاجات جسده، ويتسامى فوقها ويقمعها، ولا يستجيب لها إلّا عن طريق الزّواج الشّرعيّ.
ومن المرذول والمُحرَّم في المجتمع السّلفيّ أو البطركيّ التّلصُّصُ على جسد الآخَر، سواءٌ أكان رجلا أم امرأة (كما فعل الطّفل سامي مع مسرّة ابنة الحلوانيّ)، أو النّظر إلى الوجه مباشرة (كما فعل سامي نفسه مع امرأة خاله)، ومن المُستقبَح أيضاً ذكرُ اسم المرأة أمام الأغراب (كما فعل سامي أيضاً عندما ذكر أسماء عمّاته لعامل النّجار)، ويُعَدُّ هذا كلّه خرقاً لآداب السّلوك التي كانت أسرته تحرص عليها، وتحثّه على العمل بها، وقد ظلّ أهله ينظرون إليه باستصغار وازدراء فترة طويلة، لأنّه ارتكب هذه المحظورات جميعاً، مع أنّه كان طفلا حين وقع فيها. ووفق السّياق نفسه استنكر (الحاجّ قدري) مُزاحَ جيرانه التّجّار حول (القدرة الجنسيّة) لأحد معارفهم، وعدَّ الحديثَ عنها من الموضوعات المعيبة التي لا يجوز للرّجل أن يجعلها موضوعاً للتّندر والتّسلية.
وفضلا عن ذلك، تناولت الرّواية (الجسد) من حيث هو رمزٌ للرّجولة الكاملة أو الأنوثة المُستملحَة، ورصدت تهاوي جسد الحاجّ قدري بعد أن أتى الحريقُ على محلّاته ومصنعه الكبير، وفقد القدرة على القيام بالأعمال التي كان يقوم بها في الماضي، ورأى سامي أباه عقب الحريق “محنيّ الظّهر، مهشّم الرّوح، وهو الذي اعتاد أن يراه واقفاً كنخلة باسقة”، وحدث الأمر نفسه لنسيبه الحاجّ بكري، إذ أصابه فالجٌ أعاقه عن الحركة، كما وُصِمَتْ (شمس) بـ(العجوز) لأنّها أباحت لنفسها الزّواج من (سامي) الذي يصغرها بأربعة عشر عاماً، وعُدَّتْ منتهِكةً للأعراف الاجتماعيّة السّارية، لأنّ جسدها يفتقر إلى النّضارة والحيويّة اللّتين تؤهّلانها للزّواج من شابّ في رأيهم، وحاول أهُل زوجها تطليقَها منه مراراً فلم يفلحوا، كما سخر منها جيرانُها للسّبب نفسه، حتّى (المعارض عادل) استنكر زواجَها من سامي، وعدّ ما قامت به احتيالا على صديقه، وتصابياً من فتاة عانس لم تعد قادرة على جذب الرّجال، وعدّ إهمالَها لجسدها، وعدمَ الحرص على تزيينه دليلاً على هرمها وكونها أشبه بالرّجال منها بالإناث، وهو ما يكشف عن بطركيّتهفي النظّر إلى المرأة بشكل عامّ، وإلى الجسد بشكل خاصّ، مع أنّه يدّعي (الثّورة)، ويرفع رايتها، ويحارب من أجل وطن جديد.
ومن علامات الشّيخوخة في الرّواية (البرودةُ) التي تطال الجسدَ، وتُفقِده الحيويّة والنّضارة الملازمتين للجسد الشّابّ، وقد انتعش جسدُ شمس، وتجاوز برودته التي اكتسبها خلال تربيتها البطركيّة التي تلقّتها في طفولتها، إذ كانت أمُّها ترى في جسدها وعاءً للدّنس، وحقلا افتراضياً للوقوع في مطبّ العيب والحرام، ولذا أدارت ظهرها إليها، وقمعت متطلَّبات جسدها، وقد تضاءلت هذه البرودة منه، وطفق يستعيد حيويّته وحرارته من جديد بعد أن أقامت (شمس) علاقة افتراضيّة مع الشّاعر الرّهيف يوسف عبر إحدى وسائل التّواصل الاجتماعيّ، وكانت هذه البرودة من السّمات التي جذبت (سامي) نحو (شمس)، وجعلته يتذكّرها طويلاً بعد أن لامس أصابعها النّحيلة الباردة (ص 125)، وحين أتيح لـ(شمس) أن تتزوّج منه استعاد جسدُها حرارته وحيويّته أيضاً، وتخلّقت فتاةً جديدة، وأمست تنظر إلى الأشياء من منظور آخر: “كلّ ما في الكون صار جميلاً، حتّى ما كان عادياًّ أو قبيحاً، اكتسى بعينيها حلّة قشيبة، الثّياب القديمة استعادت رونقها، الألوان صارت أشهى (….)، وكأنّها حين قرّرت أن تكون سعيدة أرسلت إشارة إلى كلّ الأشياء من حولها” إنّني سعيدة فاسعدي”، فتجاوبت تلقائيّاً مع إشارتها تجاوب المحبّ المتعاون القادر” ( ص149)، كما ساعدها زواجها من سامي على الاقتراب “من أناها التي اغتربت عنها لسنوات” (ص175)، حتى إنّ سامي وجد في تفاعله مع جسدها عند زواجهما متعة كبيرة لا تُضاهى، جعلتْه “في حالة من الذّهول كمن أصابه مسٌّ”، وقد أفقدتْهُ المتعةُ التي أحسّ بها الإحساسَ بالمحيط من حوله، وجعلتْه يستحضر صوراً متلاحقة لحالات لم يسبق له أن عاشها، وتذكّر “رائحة الجسد، ونعومة البشرة، وملمس النّهدين”، وهتف في داخله من النّشوة : “يا إلهي أيّ ليونة وأيّ سحر!” ثمّ استحضر “صورة وجهها وهو في أوج نشوته”،فهتف مأخوذاً: “هذا هو جسد المرأة إذن، وهذا هو العالم الخفيّ الذي يطارده الجميع، وغاب عنه وحده”(ص-145)، لكنّ المجتمع البطركيّواجه (انتعاش) شمس و(توهُّج) جسدها بسلاح القسوة والقمع والسّخرية، غير أنّها لم تتراجع عمّا ألفتْه من حماسة أمام سطوته، ولم ترم السّلاح، وبقيت تحارب طواحينه الهوائيّة المتهالكة حتّى النّهاية.
ومع أنّ (شمس) سعت إلى إشباع حاجتها الجنسيّة عن طريق الزّواج إلا أنّها أخفقت في الاحتفاظ بزوجها بسبب اضطّراره إلى الهجرة، وانعدام الظّروف التي تسمح له بالبقاء في مدينته ووطنه، كما أنّ صديقتها (ناهد) لم تفلح هي الأخرى في تلبية هذه الحاجة من خلال علاقتها غير الشّرعيّة مع الأستاذ جلال، وهكذا خسرت المرأتان إمكانيّة إرواء ظمأ جسديهما، كما أخفق (الزّواج الشّرعيّ)، الذي احتكمت إليه شمس، في تحقيق ذاتها وتوفير السّعادة لها، وفشلت (العلاقة غير الشّرعيّة)، التي أقامتْها صديقتها ناهد مع الأستاذ جلال، في توفير الاستقرار لها أيضاً، وكان هذا دليلاً دامغاً على أنّ الأوطان المأزومة لا يمكن أن تساعد في تحقيق ذوات أبنائها على الوجه الأمثل، سواءٌ أتمّ ذلك بزواج شرعيّ أم من دونه، فالزّواج يمكن أن يغدو هو الآخر شكلاً من أشكال العلاقة المُجهَضة في سياق مأزوم لا يوفّر شروط الحياة الهنيّة والكريمة لأبنائه.
آليّة التّشكيل الفنّيّ
أعادت رواية لميس الزين الألق إلى فنّ الحكاية المهجورة، واستعادت القارئ الشَّغوف بفعل الحكي إلى صفّها، وأحسنت في سرد متن حكائيّ جذّاب، ولم تسعَ خلف التّقليعات الرّوائيّة، أو أشكال القصّ الحداثيّة رغبة في إبهار القارئ، أو اكتساب إعجابه، بل حرصت على تقديم خطاب روائيّ ممتع، متّكئةً على تراث حكائيٍّ عريق أعار اهتماماً لفعل الحكي نفسه، فاستمدّت منه طريقة توليد قصّة من قصّة مستندةً على متن حارٍّ عاشه المتلقّي، وحكاية تابع حلقاتها السّرديّة في حيّه أو مدينته، أو شاهد مثلها على شاشة التّلفزيون، أو سمع بمثلها من جيرانه وجلسائه، ولهذا فالسّرد عندها لا يتجاوز ما ألفناه في عمود السّرد الكلاسيكيّ من استهلال شائق، وحلقات سرديّة متنامية، وحبكة طليّة قادرة على شدّ القارئ، والإمساك بتلابيبه حتّى ينتهي من آخر سطر بين يديه، ولا نعدم في مثل هذا النّوع من السّرد وجود بعض الانزياحات الزّمنيّة التي تُحدِث قطعاً في تسلسل الحكاية المسرودة، وانحرافاً في مسارها، فتجعل الكاتبة تعود إلى الوراء قليلا متّكئة على تقنيّة (الخطف خلفاً/ الفلاش باك)، لتربط بين حاضر الشّخصيّة وماضيها، وتحيط القارئ علماً بما يساعده في فهم الشّخصيّة والإحاطة بتصرُّفاتها (ص 124)، وإيجاد صلة وثيقة بين ما آل إليه حالُها في الحاضر وبين ما كانتْهُ في الماضي، ومن ذلك استخدامُ الكاتبة لهذه التّقنيّة في استعادة شمس لطقوس موت والدها، ووداعها له بطريقة طفوليّة كشفت عن مدى براءتها وهشاشة وعيها (ص225).
وقد أحسنت الكاتبة في استخدام الوصف السّردي الخلّاق، ولاسيما في وصف البقعة السّريّة أو (الفناء الخلفيّ)، ووظّفت الحوار في الكشف عن طبيعة الشّخصيّة وثقافتها، وأرهصت بما يمكن أن يصدر عنها من أفعال، ونزعت إلى السّخرية في انتقادها للأسرة البطركيّة ومفاهيمها، كما وظّفت الشّتائم والكلمات البذيئة في تشكيل نصٍّ يتناسج مع السّياق الذي يتشكّل فيه، ويندرج ضمنه، ويعبِّر عن منطوق الشّخصيّات، ووعيها، ويكشف عن الشّريحة التي تتحدّر منها.
وفي مجال استثمار الوثيقة نلحظ أنّ الرّواية أعرضت عن بناء نصٍّ واقعيٍّ يُطابِق مرجعَه، وعمدتْ إلى تشكيل خطابٍ تخييليّ، لا يُبقي الوثيقة كما هي، بل يمتصُّها ويجعلها تذوب في نسيجه، بحيث تصبح عنصراً سردياً في بنيته، كما في الصّفحتين ( 162 و227)، وحين لاتذوب الوثيقة في النّسيج السّرديّ، وتنفصل عنه (كما في ذكر المعلومات الخاصّة بسوق المدينة المحترق التي وُضِعتْ في هامش الصّفحة- ص163 ) تغدو الوثيقة عندئذ عكّازاً تواصُليّاً يجعل همّه إكساب النّصّ “صدقيّة” تاريخيّة ومرجعيّة تستقي أهميّتها من حرصها على محاكاة الواقع، لا الإيهام به، وعندئذ تمسي الوثيقة حشواً وفضلة، ويمكن حذفها والاستغناء عنها.
وقد أفلحت الكاتبة في استثمار الجسد وجعله عنصراً رمزيّاً في تصوير الشّخصيّة، واكتناه الدّلالة، كما أفلحت في استخدام الحجاب والألوان بوصفهما برهاناً على وجود حاجز يحول دون تواصل الشّخصيّة مع الآخر، كما نجحت في جعل الطبيعة عنصراً سردياً يرمز إلى النّقاء والصّفاء والسّلام والأمان، والخلاص من كل ما له علاقة بالناس والحياة الماديّة الملوّثة على الأرض.
وفي ظنّي أن نصّ (الفناء الخلفيّ) من النّصوص الشّائقة التي ستعلق بذاكرة القارئ طويلاً، لما فيها من براعة في السّرد، وقدرة على التّشويق، واختيار ثيمات حكائيّة صادمة وراهنة معاً.
ناقد سوري