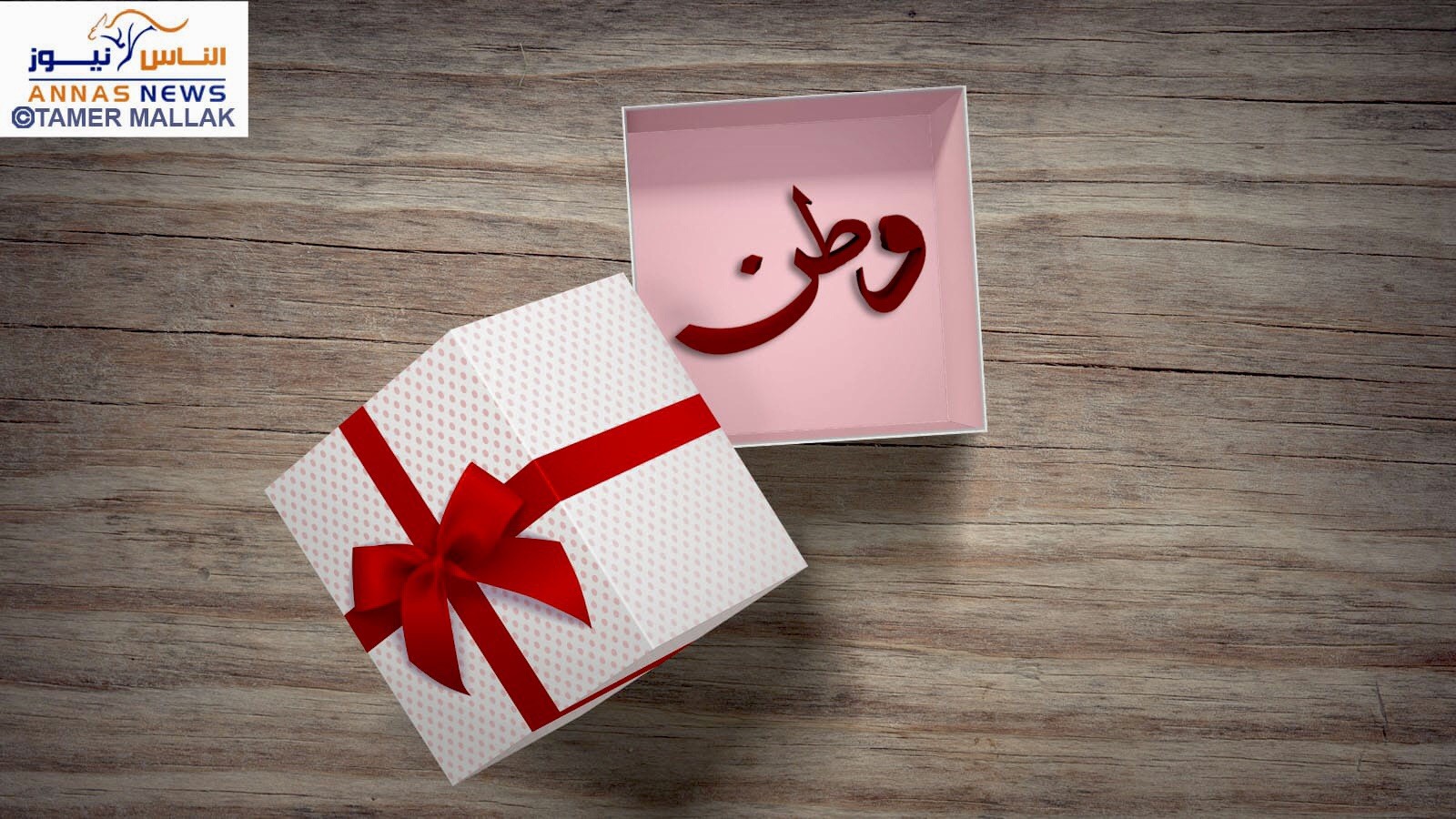د. خالد عبد الكريم – الناس نيوز ::
تُعد هذه الصفحات إبحاراً في العوامل التي سبقت الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، مع تناول تداعيات غياب الإدراك التاريخي العميق لطبيعة ذلك الحدث المفصلي. ونتيح المجال للإطلاع على رؤى خارجية شبه محايدة، تعبّر عن اهتمام جاد بقضايا اليمن، وتطرح زوايا نظر جديدة قد تفتح آفاقاً لفهم الأزمة اليمنية.
هيلين لاكنر، باحثة وكاتبة بريطانية، عملت في اليمن منذ السبعينيات وظلت خمسون سنة تكتب في الشأن اليمني، في حديث لها مبني على تجربة شخصية تناولت الجمهوريتين السابقتين لدولة الوحدة – الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – مستعرضةً أوجه التباين والالتقاء بين النظامين، قبل أن تنتقل إلى مرحلة الوحدة اليمنية وتقدم رؤيتها التحليلية الخاصة بشأنها.
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
دولة تميّزت بنظام مركزي صارم ذي طابع اشتراكي، احتكر فيه الحزب الاشتراكي اليمني السلطة، وركّز على التنظيم المؤسسي والانضباط الإداري، في ظل نظام قانوني وأمني واضح المعالم.
لكن، كما تشير لاكنر، فإن هذه الدولة واجهت إخفاقات ذات جذور داخلية وخارجية. فعلى الرغم من هشاشة البنية الداخلية، والتوترات المناطقية، والقصور الإداري، فإن العامل الخارجي لعب دوراً جوهرياً. إذ وُجدت الدولة الناشئة في بيئة إقليمية معادية، ترفض وجود نظام يساري في جنوب الجزيرة العربية. وأسهمت الحرب الباردة والتجاذبات الإقليمية في عزل اليمن الجنوبي والتضييق عليه إقتصادياً وسياسياً، ما أعاق قدرته على تجاوز أزماته البنيوية.
وفي قراءة نقدية للتجربة اليسارية خلال السبعينيات، تُشير الباحثة إلى أن السياسات الاشتراكية الراديكالية – لا سيما التأميمات الواسعة – لم تفرّق بين كبار الملاك وصغار التجار والحرفيين، مما أفضى إلى اختلالات عميقة في بنية الاقتصاد.
لكن، رغم هذه التحديات، تميّزت التجربة الاشتراكية بمكاسب اجتماعية ملموسة في مجالات التعليم، والصحة، وتمكين المرأة. وقد تبنّت الدولة رؤية تقدمية نسبياً في هذه القطاعات مقارنة بسائر بلدان المنطقة آنذاك.
الجمهورية العربية اليمنية
تَمثّل نظام الحكم فيها بنموذج تقليدي هجين، يدمج بين البيروقراطية الحديثة والأعراف القبلية، مع هيمنة العلاقات الشخصية والمحسوبية في عملية اتخاذ القرار، مما خلق تباينات في تطبيق القانون ومرونة غير منضبطة في أداء مؤسسات الدولة.

تحدّثت لاكنر بإيجاز عن مرحلة عدم الاستقرار السياسي في شمال اليمن (1970–1978) التي شهدت سلسلة من الانقلابات والتحولات المتسارعة. لكنها توقّفت عند التحوّل النوعي في السبعينيات والثمانينيات، حين بدأت الجمهورية العربية اليمنية بتحقيق بعض التقدّم في مستوى المعيشة، مستفيدة من التنافس بين الكتلتين الغربية والشرقية، وسعي الغرب، خاصة الولايات المتحدة، إلى دعم حلفائه بمساعدات مالية وتنموية ضمن استراتيجية “احتواء الشيوعية”.
تلقت صنعاء دعماً سخياً، خصوصاً من دول الخليج، وبدت حينها مؤهلة لتبني مشروع تنموي طموح، على غرار التجارب الآسيوية الناجحة (كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة). إلا أن الدولة فشلت في تحويل تلك الفرصة إلى مشروع نهضوي شامل، رغم بعض الإنجازات الجزئية في مجالات مثل الاتصالات – وهو ما شاهدته الباحثة لاكنر أثناء تواجدها في صنعاء في تلك المرحلة.
الجمهورية اليمنية
انتقلت لاكنر للحديث عن الوحدة اليمنية، التي وصفتها بأنها كانت حلمًا وجوديًا لمعظم اليمنيين. لكنها لفتت إلى وجود دوافع جانبية ومادية ساهمت في تسريع الوحدة، منها الدافع الاستهلاكي في الجنوب، بعد تحسن نسبي في دخول المواطنين أواخر الثمانينيات. إذ ترافق توفر المال مع نقص في الخيارات، وبرزت رغبة شعبية في نمط حياة أكثر انفتاحاً وثراءً.
وقد ربط الجنوبيون، بحسب تحليلها، بين الوحدة وتحقيق تطلعاتهم لا في بعدها الوطني فقط، بل أيضاً في ما تمنحه من حرية استهلاكية ورمزية، كالسيارات الحديثة، والسفر، والبيوت الخاصة، ونمط الحياة “الرأسمالية”.
كما لم يُبدِ كثير من الجنوبيين اعتراضاً على زوال بعض الامتيازات المتقدمة لديهم في مجالي الصحة والتعليم.
في الطرف الآخر، كان الشماليون – وفق شهادة لاكنر – يتطلعون إلى أمرين أساسيين:
1.تنظيم تعاطي القات، كما في الجنوب، حيث كان متاحاً فقط في عطلات نهاية الأسبوع، خلافاً للشمال الذي كان القات فيه متاحًا طوال الأسبوع.
2.تطبيق قانون الأسرة الجنوبي، خاصة من قبل النساء، لما فيه من حقوق متقدمة، منها المساواة في إعالة الأسرة، وتقييد تعدد الزوجات.
وتؤكد لاكنر أن أبرز ما ميّز السنوات الأولى من عمر الوحدة اليمنية هو الانفتاح السياسي الواسع وازدهار الحياة الحزبية وحرية التعبير، خصوصاً خلال عامي 1991 و1992، واصفة تلك المرحلة بـ”المذهلة”.
ثم تحدثت هيلين لاكنر عن الحرب الأهلية الأولى في الدولة الموحدة عام 1994، مشيرة إلى التناقض البنيوي العميق بين نظامين مختلفين: رأسمالي تقليدي في الشمال، واشتراكي مخطط في الجنوب.
وتوضح لاكنر أن مشروع الوحدة لم يُبنَ على أسس تكاملية أو مشروع وطني مشترك، بل على تفوق طرف على آخر. كما تؤكد أهمية البُعد الشعبي في الدفع نحو الوحدة، في مقابل فشل النخب السياسية في تحويل ذلك الحلم إلى واقع مستدام.
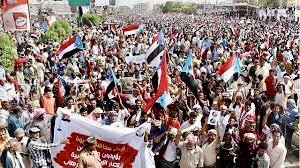
نحو أفق مختلف لليمن
بعد أن تعمقت في الماضي القريب. غيرت السيدة لاكنر مجرى الحديث نحو مستقبل اليمن، الذي لا يكتمل دون فسحة أمل، ورؤية تتجاوز اللحظة الراهنة نحو ما يمكن أن يكون عليه اليمن، لو أُتيحت له فرصة حقيقية للنهوض.
إن الرؤية التي أُختتمت بها حديثها، لم تأتِ من باب التفاؤل العاطفي، بل من إيمانٍ متجذر بأن التغيير ممكن، وأن اليمن ليس قدره البقاء في دوامة الانهيار. هذه الرؤية تضع نصب أعينها دولة حديثة تحكمها المؤسسات ويعلو فيها صوت المواطن، حيث تُعاد صياغة الأولويات لصالح الإنسان وكرامته.
يبدأ هذا التحول ببناء مشروع ديمقراطي حقيقي، يرتكز على إصلاحات جذرية في بنية الدولة، وينطلق من تغيير عميق في التعليم، باعتباره الأساس لأي تحول اجتماعي أو سياسي. ولا يمكن توقع نتائج ملموسة في هذا المجال قبل مرور أكثر من عقد على الأقل، وهي فترة ضرورية لتكوين جيل جديد من الفاعلين القادرين على كسر القوالب القديمة وإنتاج واقع مختلف.
تتسع هذه الرؤية لتشمل بنية تحتية متطورة، واقتصاداً نابضاً بالحيوية، قائماً على المعرفة والعدالة، مع إدارة متوازنة للموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، التي عانت من سوء الاستخدام لعقود، وتتطلب سياسات بعيدة المدى تقوم على الحفاظ والتجديد. كما تُطرح فكرة إعادة إحياء الثروات البحرية والزراعة المطرية، بشرط أن تُدار بأساليب تراعي البيئة وتقلل من استنزاف الموارد.
الجانب التنموي كذلك ليس مغيّباً، بل يُعاد فيه الاعتبار لقطاعات ظلت مهمشة، كالثقافة والسياحة والحرف والتقاليد، في إطار رؤية أخلاقية للتنمية لا تقوم على الربح فقط، بل على حفظ الموروث وتعزيز الهوية.
أما من الزاوية الاجتماعية، فإن المجتمع المنشود هو ذلك الذي تُكفل فيه حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة، ويُحتفى فيه بالتنوع الثقافي، حيث تُصان الموسيقى والأدب والعمارة والفولكلور والسينما كعناصر تكوينية للهوية الوطنية، لا كترفٍ هامشي.
وفي الإطار الإقليمي والدولي، فإن الدعم الحقيقي لليمن لا يُقاس بما يُقدم من أموال أو مساعدات، بل بما يُكف عنه من تدخلات وضغوط. الحاجة قائمة إلى شريك جوار قوي يساند، وإلى موقف دولي نزيه يُنصف اليمن كدولة ذات سيادة، لا كملف إغاثي دائم.
في ختام حديثها، الباحثة البريطانية التي تحب اليمن وتصف شعبه بالرائع. أخبرتني، “تلك خطوطٌ عامة لرؤية قابلة للتطبيق متى ما وُجدت الإرادة الصادقة، محلياً وخارجياً”.
الكاتب رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية – فرنسا.