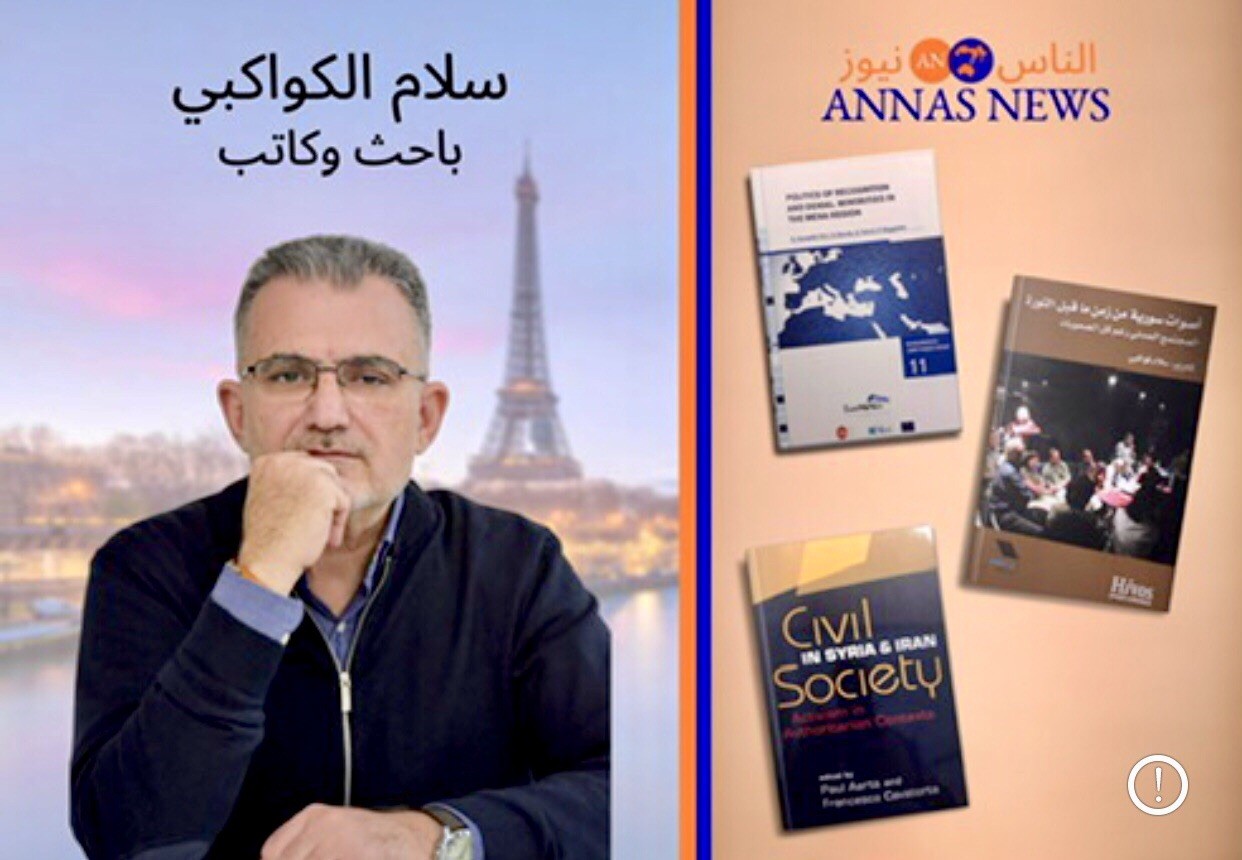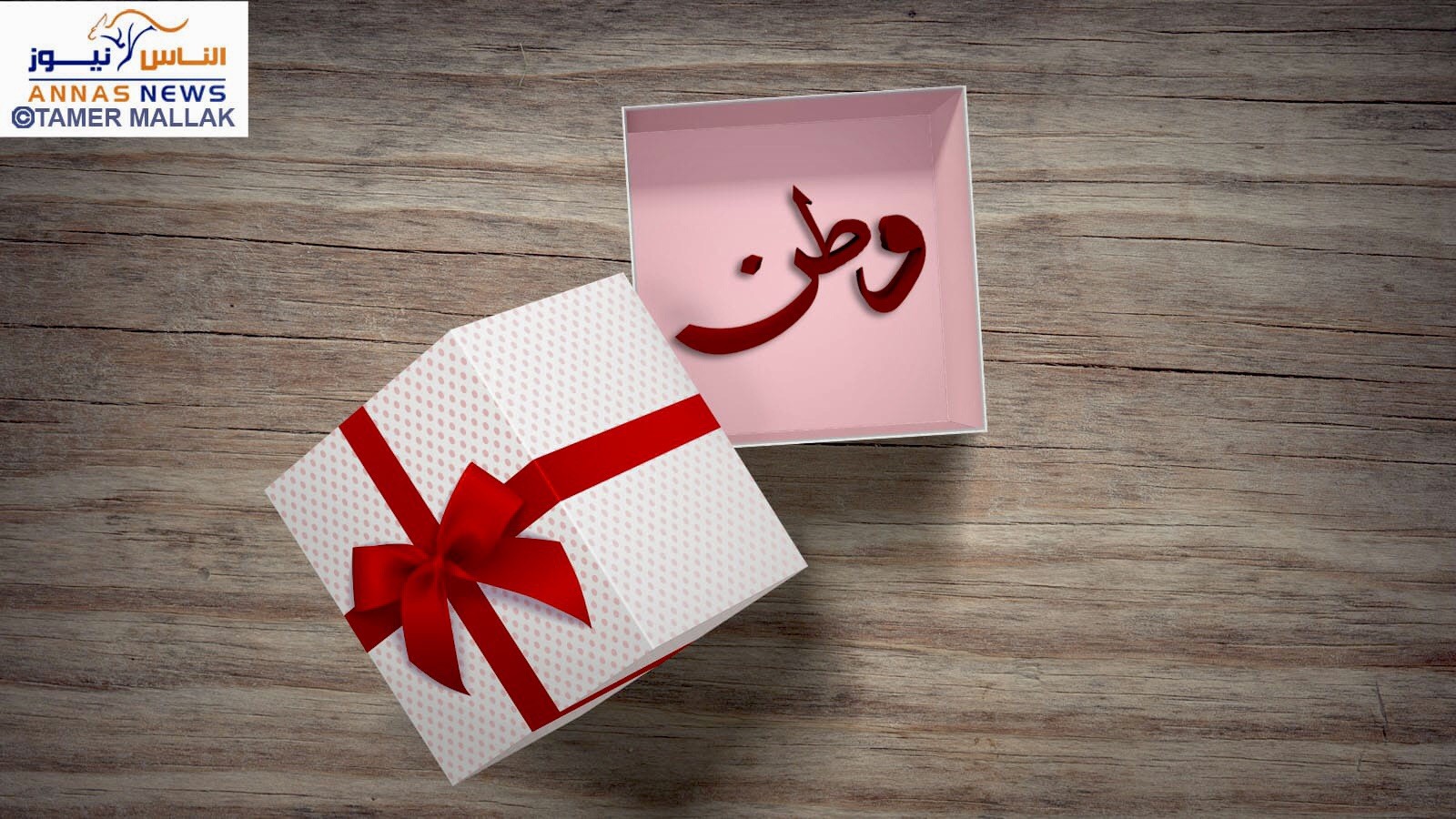ميديا – الناس نيوز ::
المدن – د . سلام الكواكبي – غرّد عالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران مؤخّرًا التالي: “يجب علينا ألا نفكر بعد الآن في مجتمع أفضل، بل في كيفية تجنّب الأسوأ.”
هذه العبارة، رغم بساطتها الظاهرية، تختصر تحوّلًا جذريًا في المزاج السياسي والاجتماعي للعالم اليوم.
ولم يعد مستغربًا أن نسمع مفكرين وقادة رأي يقولونها علنًا: لم نعد نحلم بتقدم مبهر، بل نخشى السقوط الحر. وقد لا نجد مكانًا تتجلى فيه هذه الفكرة المؤلمة بوضوح أكثر من سوريا، تلك البلاد التي انتقلت خلال عقد من الزمان من أمل التغيير إلى صراع النجاة، ومن طموحات إصلاح مؤسسات الدولة إلى محاولات بائسة لتفادي الانهيار الكامل والسقوط في العدمية.

حين خرج السوريون إلى الشوارع عام 2011، لم يكونوا يحملون مطالب مستحيلة أو خيالية. كانت الشعارات بسيطة: حرية، كرامة، عدالة. أراد الناس دولة عادلة، تحترم الحقوق وتكفّ عن إذلالهم في مكاتب البيروقراطية وأقبية الأمن. كانت تلك اللحظة مشبعة بالأمل، وكان من الممكن أن تكون بوابة لانتقال سياسي هادئ وعقلاني. لكن النظام رد بالقمع، والمجتمع الدولي بالتردد، وانقسمت المعارضة بين تيارات متنافرة لم تنجح في بلورة مشروع جامع. ومع انزلاق البلاد إلى العنف، ثم الحرب الشاملة، انهار كل شيء تقريبًا: مؤسسات الدولة، الاقتصاد، النسيج المجتمعي، والحد الأدنى من الثقة بين المواطن ومن يحكمه.
في السنوات الأولى من الثورة، ظلت آمال التغيير حية. كان هناك من يعتقد أن الأمور، رغم تعقيدها، ستؤول إلى حل سياسي، إلى تسوية تاريخية تعيد بناء الدولة على أسس جديدة.
لكن مع تصاعد العنف وتدخل القوى الإقليمية والدولية، بدأ المزاج يتغيّر .
لم تعد المطالبة بدستور جديد، أو قضاء مستقل، أو إعلام حر، أمورًا ذات أولوية. صار الناس يبحثون عن الحماية، عن الكهرباء، عن الخبز، عن الهروب.
تراجعت الأولويات الوطنية أمام الأولويات الفردية واليومية. أصبح الحفاظ على الحياة هدفًا بحد ذاته. من يسكن في مناطق النظام، يعاني من اقتصاد مدمر، عملة منهارة، وفساد مستشرٍ. ومن يسكن في مناطق المعارضة، يعيش فوضى أمنية وسياسية، حيث تتنازع الفصائل المسلحة النفوذ. ومن هو في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد، يجد نفسه بين إدارة غير معترف بها وتحديات مستمرة من الداخل والخارج.
أما من هم في الشتات، فقد تقطعت بهم السبل بين اللجوء والمنافي والهويات المكسورة.

لم تعد سوريا في موقع الدولة المتعثرة فحسب، بل تحولت إلى نموذج للدولة المنهارة جزئيًا، حيث توجد سلطة بلا سيادة، ومؤسسات بلا وظائف حقيقية، وسكان بلا حقوق واضحة. الهشاشة أصبحت قاعدة لا استثناء، والاقتصاد لا يقوم على الإنتاج، بل على الحوالات والمساعدات.
التعليم يتراجع، والنظام الصحي ينهار، والخدمات الأساسية باتت من الكماليات.
في هذا الواقع، من الطبيعي أن يتراجع النقاش السياسي لصالح أسئلة البقاء: كيف نأكل؟ كيف نتدفأ؟ كيف نعالج أولادنا؟ كيف نمنع اعتقالهم أو تجنيدهم أو تهريبهم إلى البحر؟
كل ما سبق خلق مناخًا عاماً من اللامبالاة السياسية، ليس لأن السوريين لا يهتمون بمصير بلادهم، بل لأنهم أرهقوا من التفكير فيه.
أكثر من عشر سنوات من الدم والتشريد والقصف والحصار جعلت كثيرين يتجنبون التفكير في المستقبل، لأنه ببساطة مرعب. والأخطر من ذلك أن هذه اللامبالاة أصبحت آلية دفاع نفسي. الإنسان حين يُحاصر بين الخوف من الغد والعجز عن تغييره، يُفضل ألا يتوقع شيئًا، حتى لا يصاب بالخذلان من جديد.
ومع ذلك، هناك من يقاوم هذا الانزلاق الكلي إلى اليأس.
ثمة مبادرات مدنية تظهر بين حين وآخر: مدارس أهلية، مشاريع صغيرة تقودها نساء، مبادرات ثقافية، ورشات عمل فنية، محاولات لتوثيق الذاكرة الجماعية، أو توفير مساحة آمنة للأطفال للتعلّم واللعب.

هذه المشاريع لا تغيّر موازين القوى السياسية، لكنها تعيد التذكير بأن الروح السورية لم تُكسر بالكامل. لا يزال هناك من يحاول خلق حياة من تحت الركام، ومن يحلم بمستقبل أفضل، ولو عبر خطوات صغيرة جداً.
غير أن هذه الجهود، على أهميتها، تبقى عرضة للانهيار في أي لحظة. طالما لا يوجد حل سياسي جذري يُنهي حالة الانقسام، ويضمن حقوق الجميع، ويعيد الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، فإن أي مبادرة تبقى مجرد جهد فردي مؤقت، لا يمكنه مواجهة منظومات من الفساد والعنف والإقصاء. وهنا تحديدًا تكمن المعضلة: كيف نبني الأمل في بلدٍ لا يزال عالقاً بين قوى تتصارع عليه، لا لأجله؟
السؤال الأعمق الذي تطرحه الحالة السورية على العالم اليوم هو: هل بات “تفادي الأسوأ” هدفًا بحد ذاته؟ هل تراجع الحلم الإنساني بمستقبل أفضل إلى مجرّد رغبة في تثبيت الحاضر؟ الجواب المؤلم، على ما يبدو، هو نعم.
وسوريا ليست استثناءً، بل ربما مرآة لما يحدث في أجزاء كثيرة من العالم: انحسار الديمقراطية، تصاعد القومية المتطرفة، أزمات اللاجئين، تفكك العقد الاجتماعي، حتى في أعتى الديمقراطيات الغربية.
في زمن كهذا، قد لا يكون غريبًا أن تصبح “النجاة” هي الغاية.
لكن الخطر يكمن في أن تتحول النجاة إلى أفق نهائي. فالمجتمعات التي تتوقف عن الحلم، تتوقف عن التقدّم، وتفقد قدرتها على التجدّد.
وسوريا، بكل جراحها، لا تزال بحاجة إلى من يعيد لها الحلم، لا بوصفه وهماً سياسياً، بل كفعل يومي للنجاة بالكرامة.
قد لا نكون الآن قادرين على تخيّل دولة مثالية، ولكن هذا لا يعني أن نقبل بمجتمع محطم بلا أفق. ما بين الحلم والانهيار، لا تزال هناك مسافة، ومسؤوليتنا أن نحافظ عليها، ونوسّعها، ونؤمن أنها جديرة بالحياة.
باحث وكاتب سوري فرنسي مرموق – مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس.