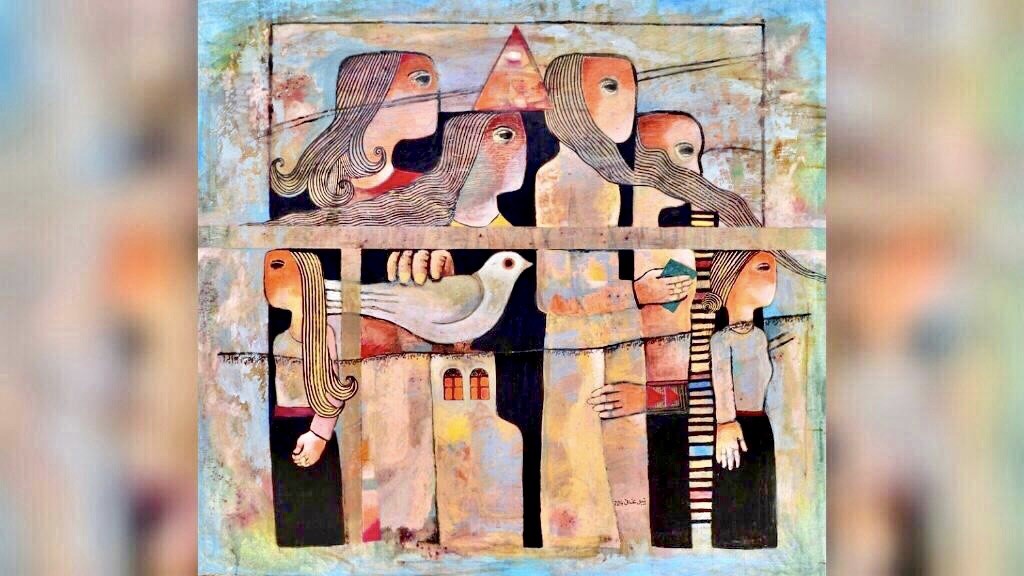د . ممدوح حمادة – الناس نيوز :
أكره اللصوص، وخاصة أولئك الذين يسرقونني شخصيا، تنظم لهم مخيلتي الحاقدة حفلات تعذيب سادية و بقوة خفية تمنحني إياها السماء عادة، أتمكن من التعرف عليهم وعلى مكان وجودهم وبقوة سحرية أسوقهم إلى عند قدمي وأنكل بهم تنكيلا تعجز عقول الأجهزة القمعية المبدعة عن الإتيان بمثله، وإذا ارتبط القتل أو التعذيب مع عملية السرقة فإنني أنهي مصير السارق بالقتل حتما ولكن بعد أن يكون قد ندم على اليوم الذي ولد فيه، صحيح أنني حتى الآن لم أتمكن من العثور على سارق واحد من أولئك الذين سرقوني، طبعا باستثناء أولئك الذين يتربعون على قمة الهرم الذين سرقوا البلاد كلها وأنا مسروق مثلي مثل بقية أفراد الشعب، وساكت مثل بقية أفراد الشعب وسأكون من المحظوظين إن لم أتعرض لتنكيلهم، هؤلاء لا أتحدث عنهم هنا فرغم وجودي في بلد أجنبي أشعر أن هناك فرعا كاملا مخصصا لمراقبة لساني وحتى تفكيري وأضعهم دائما خارج نطاق انتقامي، أنا أتحدث عن اللصوص العاديين الصغار الذين يمكن لي التعامل معهم ولكن هؤلاء بخلاف لصوص قمة الهرم يصعب التوصل إلى معرفتهم فكيف لي أن أعرف مثلا ذلك اللص الإلكتروني الذي سرق مدخراتي التي جمعتها عدة أعوام؟ كيف أعرفه وكيف أقبض عليه؟ هذا عاقبته في مخيلتي بدون رحمة وكنت عندما أجلده بالكابل الرباعي أعض دائما على شفتي لدرجة أن جرحا لا يلتئم تشكل هناك كان يظنه البعض أثرا لقبلة عنيفة، بسبب هذا اللص الحقير بقيت أجمع الزجاجات الفارغة لأكثر من عام لكي أوفر لقمة العيش، هذا لو قبضت عليه لشنقته من بين فخذيه دون أن تأخذني به رأفة، ولكن هيهات فلكي أقبض على هذا الكلب يلزمني توظيف إمكانيات تفوق مدخراتي التي سرقها ذلك الحقير بأضعاف ، على العموم لا داعي للقلق فكل ذلك الإجرام كان يحدث فقط في مخيلتي فأنا لم أقبض على أي لص سرقني أو سرق غيري وإن حدث ذلك فلن أقوم بفعل شيء سوىالمطالبة باسترداد المسروقات أو التعويض عنها ولن أطالب بأكثر مما ينص عليه قانون العقوبات الجزائي، ربما ، أقول ربما أبصق في وجهه إن كنت منفعلا أو أصفعه وأطرحه أرضا وأدوس عليه ولكنني على الأغلب سأنسى الموضوع كليا، سأنساه حتى إن لم يتم العثور على اللص فالزمن كفيل بمحو كافة الخيبات.
إضافة إلى اللصوص أكره حمل الأكياس وأفضل ترك يدي حرتين، والسبب في ذلك قد يبدو غريبا بعض الشيء ففي فترة مراهقتي كنت أشاهد أفلام الكاو بوي بشراهة، ويمكن القول إنني لم أفوت فيلما عرض في صالات السينما في بلدي لم أشاهده، ولشدة تفاعلي مع هذه الأفلام كنت أحيانا عند مرور أحد بقربي أضع يدي على المسدس الذي كنت أفترضه على جانبي بحركة آلية ثم انتبه أن الفيلم قد انتهى، وأنني في مدينة لا يحمل فيها المسدسات إلا رجال المخابرات وأذناب المخابرات فأعود إلى الواقع، وفي إحدى هذه المرات أردت أن أضع يدي على مسدسي المفترض فكان في يدي كيس أعاقني عن فعل ذلك، لم يكن في الكيس أشياء مهمة علبة سجائر وأوقية من المكسرات، تصوروا بأنني كنت سأموت بسبب كيس كان في يدي لو أنني كنت في الغرب الأمريكي المتوحش، تكرر ذلك مرة أخرى فأقلعت نهائيا عن حمل الأكياس في يدي، ولذلك تربطني علاقة مقدسة بحقيبة الكتف، أعلقها على كتفي وأنساها تماما، كراهيتي للأكياس واللصوص لا تصل إلى مستوى كراهيتي للمشافي والمستوصفات، حيث إنني أشعر بالغثيان كلما دخلت إلى مثل هذه المؤسسات، وأكثر شيء أكرهه هناك هو الفحص الطبي الذي يفرضونه علينا كل عام، ولم أذهب إليه بشكل طوعي ولا مرة في حياتي.
في كل عام أتأخر عن الذهاب لإجراء الفحص في الموعد المحدد لذلك، آملا أن يتجاهلني المستوصف فأتخلص من إجراء التحاليل، لكن المستوصف لا يتجاهلني، وتبدأ مشاكلي معه من نهاية الشهر السادس، حيث أعود في أحد أيام هذا الشهر فأجد قصاصة معلقة على بابي:”عليك مراجعة المستوصف فورا”، أتناول القصاصة، أقرأها ثم أمزقها وأرمي بها في سلة القمامة، أشعر بالامتعاض قليلا ولكنني أتابع حياتي بالشكل المعتاد، وأكاد أنسى موضوع الفحص الطبي، ولكنني بعد شهر بالتحديد أعود فأجد على بابي قصاصة أخرى كتب عليها نفس العبارة:”عليك مراجعة المستوصف حالا” أمزقها أيضا وأرمي بها في سلة القمامة، وأتابع حياتي لعلهم في المستوصف ينسون أمري، ولكن العملية تتكرر بعد شهر أيضا، أعود فأجد القصاصة وأمزقها إلى أن يحل شهر كانون الأول الذي يحمل الرقم 12 من السنة ولهذا أيضا أكره الرقم 12، ففي الخامس عشر من هذا الشهر أعود فأجد على بابي نفس القصاصة وقد أضيفت إليها عبارة تهديد: “عليك مراجعة المستوصف وإلا ستتخذ بحقك كافة الإجراءات القانونية” والإجراءات القانونية هذه تعني طردي من مسكن الطلبة، عندها لا يبقى أمامي مخرج فأذهب إلى المستوصف.
أحمل سجلي الصحي وأدخل العيادات تباعا، يسألني الأطباء: (هل تعاني من شيء؟) فأجيب : (لا)، يوقع الطبيب وأمضي أنا إلى عيادة أخرى للحصول على توقيع آخر، في قسم تحليل الدم يأخذون عينة من دمي للبحث داخلها عن فيروسي الإيدز والسفلس، منظر الدم لم يكن يزعجني فقد تعرضت في حياتي لجراح كثيرة وقد اعتدت على رؤية دمي ينزف، ولكن الذي كان يبعث في نفسي شيئا من القلق هي تلك الكمامات والقفازات التي كانت ترتديها ممرضات ذلك القسم فتولد لدى الشخص إحساسا بأنه موبوء، كما أن الانتظار عشرة أيام لمعرفة النتيجة كان يبعث على الاضطراب، خاصة إذا كان الإنسان قد ارتكب إثماً دون أن يتخذ إجراءات الأمان، ومع ذلك فإن الإزعاج الذي كانت تسببه تحاليل الدم لا يقارن أبدا مع الإزعاج الذي تسببه التحاليل الأخرى التي يجب على الشخص إحضارها صباح اليوم التالي على الريق في زجاجة وعلبة كبريت.
هذه التحاليل كانت مهينة،فإضافة إلى أنها تبعث على القرف، كان حملها إلى المستوصف مشكلة حقيقية، فإن وضعت البضاعة في حقيبة الدراسة أخشى أن تنفتح علبة الكبريت أو تندلق الزجاجة بين دفاتري وكتبي، ومجرد التفكير بأنني أحملها في جيبي يبعث على الاشمئزاز، لذلك كنت مضطرا أن أحملها كل مرة في كيس منفرد أكره حمله كما قلت، وفي هذا العام أردت فعل الشيء نفسه، ولكنني لم أعثر على كيس فمزقت صفحة من إحدى الصحف الرسمية الثلاث لا أذكر أيها الآن، وقمت بلف علبة الكبريت بها، ثم مزقت صفحة ثانية من نفس الجريدة وقمت بلف الزجاجة، وضعت علبة الكبريت في حقيبة الدراسة وحملت الزجاجة لأنني خشيت أن تندلق، فقد كانت مغطاة بقطعة شفافة من كيس بلاستيكي ومربوطة حول الزجاجة بمطاطة، ماذا لو انقطعت المطاطة؟ سأحملها بيدي.
نزلت إلى الشارع أحمل بيدي الزجاجة الملفوفة بصفحة الجريدة، ولكن إحساسا تولد لدي بأن الناس جميعهم يعرفون ما الذي أحمله دفعني لأن أتوقف عند الكشك الذي كان على الرصيف كي أشتري كيسا أضع فيه الزجاجة وعلبة الكبريت.
لم يكن في الكشك أكياس بلاستيكية، كان هناك فقط أكياس ورقية بيضاء لامعة مخصصة لهدايا رأس السنة، وقد رسم على كل منها “بابا نويل” والحسناء التي ترافقه و قد كتب فوقهما “كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة”، اشتريت الكيس رغم أن سعره مرتفع قليلا ووضعت فيه الزجاجة ثم أخرجت علبة الكبريت من حقيبتي ووضعتها فيه أيضا.
صعدت إلى الترامواي وجلست هناك على مقعد منفرد ووضعت الكيس في الممر قرب المقعد وأخذت أنظر من النافذة أراقب الطريق ريثما أصل إلى المحطة القريبة من المستوصف.
كان الترامواي قد قطع ثلاث أو أربع محطات عندما شاهدت شخصا يعبر الطريق مسرعا إلى الجهة المقابلة، ينظر إلى الخلف وفي يده كيس يشبه كيسي، هكذا تصورت في بداية الأمر(كيس يشبه كيسي)، ولكن بعد دقائق، عندما اكتشفت أن الكيس الذي كان قربي في الممر غير موجود أدركت أن الكيس الذي كان في يد الرجل هو كيسي تحديدا.
شعرت بالانزعاج لأنني سأضطر لتكرار العملية، ولكن ذلك اللص كان أول لص لا أشعر نحوه بكراهية، لقد شعرت نحوه بالشفقة، ماذا سيكون انطباعه عندما ينزع صفحتي الجريدة عن الزجاجة وعندما يفتح علبة الكبريت؟
قلت في نفسي : (هدية تليق باللصوص).


الأكثر شعبية

شبح الفساد خطرٌ داهمٌ في سورية…


الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده بعد سلسلة نجاحات…