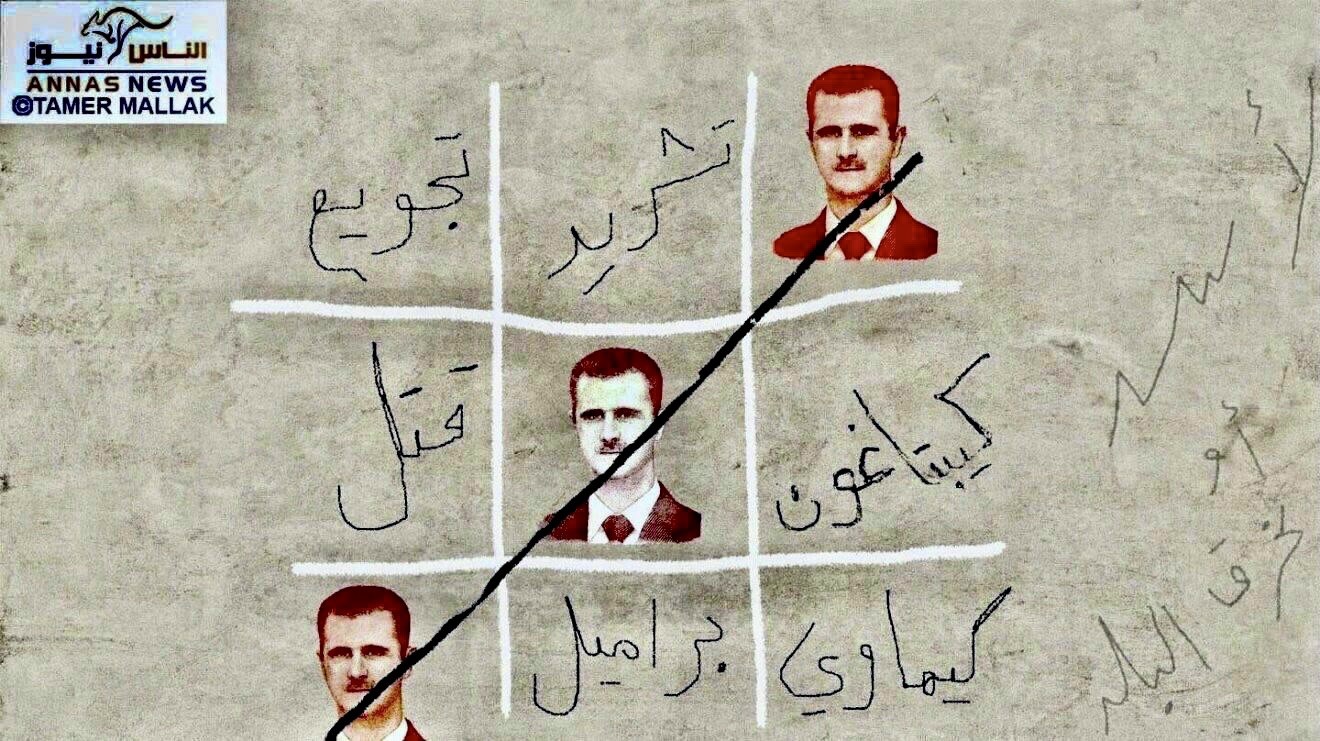[jnews_post_author]
إذ يتقدم الرئيس المنتخب بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، تظهر مقاربته للسياسة الخارجية الامريكية عمق الأزمة التي تواجه الأمة الأمريكية والتي تنمو جنبا إلى جنب مع تحديات عالمية غير مسبوقة. إذ جرت في العقد الأخير تغيرات عميقة في البيئة الجيوسياسية بعيداً عن المصالح الأمريكية إلى حد الخطورة. وتتيح لنا مقاربة الرئيس المنتخب أن نكتشف عناصر القوة التي يسعى لتجميعها لتحقيق أجنداته الطموحة. فهو يحاول أولا عبر التعيينات المقترحة لعدد من المناصب المفتاحية في إدارته الجديدة أن يجمع أكبر ما يمكن من الخبرة والفطنة السياسية ويعتمد ثانيا وبامتياز مقاربة وسطية بما يسمح بتحقيق أكبر ما يمكن من التوافقات الضرورية مع الجمهوريين. ثالثاً، ولعل في ذلك الكثير مما أنه يتطلع لبناء سياسته على مبدأ “القيادة عبر قوة المثل”.
كل هذا أمر جميل ويدعونا للتفاؤل، لكن من جهة أخرى يحمل الرئيس بايدن الكثير من الندوب التي خلفتها في سيرته فترة الرئيس أوباما. والأهم من ذلك أن الرئيس بايدن سيجد نفسه أكثر من الكثير من الرؤساء مقيدا إلى حد بعيد في خياراته. ذلك أن السياسة الخارجية الأمريكية لم تكن يوما محكومة بشكل مباشر باعتبارات السياسة الداخلية الأمريكية بقدر ما هي عليه في اليوم حيث يمر الوضع الداخلي بلحظة حرجة قلما ما مرت فيها الدولة سواء في إطار المجتمع أو بنية الدولة الفدرالية أو الاقتصاد بالطبع.
بعد الحرب العالمية الثانية أسست الولايات المتحدة زعامتها بالانطلاق من نتائج مؤتمر بريتون وودز حيث اتفقت مع حلفائها الذين دمرتهم الحرب على أساس توليها حماية التجارة العالمية وضمان انفتاحها وحماية الطرق المالحة بفضل التفوق العسكري الكاسح للبحرية الأمريكية مقابل الاحتفاظ بموقع الدولار وتماسك الحلف المعادي للشيوعية. وبعبارة أخرى، فإن الولايات المتحدة كانت ترشي حلفاءها بفتح أسواقها وضمان حرية التجارة الدولية التجارة العالمية مقابل أمنها القومي وفي مواجهة الاتحاد السوفياتي.
اليوم لا تشعر الولايات المتحدة أن هذا النظام يعمل لصالحها فيما بعد نهاية الحرب الباردة. ولقد شكل عهد الرئيس ترامب محاولة لمعالجة هذه الحقيقة ولكن بشكل اعتباطي غريزي. وبنى ترامب استراتيجيته الدولية. واستندت استراتيجيته علي حقيقة أن قاطرة الاقتصاد الأمريكي تكمن في قدرته الاستهلاكية القادرة على الاكتفاء النسبي في وقت تتداعى فيها الاقتصادات المبنية على التصدير. وبذلك عمل الرئيس ترامب على خلق منظومة عولمة مصغرة مع كندا والمكسيك وبريطانيا تستطيع الولايات المتحدة من خلالها ضمان رفاهها وأمنها الاقتصادي دون الحاجة للانخراط في العالم. وبذلك راجت الأوهام بسقوط منطق المصالح الاستراتيجية لصالح منطق المصالح الاقتصادية الكبرى والمباشرة.
وبعد أن رضخت مؤسسات رأس المال المالي للشروط الفدرالية بالخروج من الأزمة الاقتصادية عام ، شكل المنهج الجديد لإدارة ترامب انتصاراً كبيرا لرأس المال المالي ونمت في عهده تحالفات كبرى بين هذه القوى والبيت الأبيض. وتمكن الـ “وول ستريت” من الحصول على دعم جوهري الأمر الذي سمح بدوره بطفرة اقتصادية في نمو رأس المال تجلى بتراجع البطالة وانتعاش السوق.
لكن سرعان ما بدأت نتائج هذه السياسات تنعكس بحالة من السلوك الاعتباطي واختلال وتائر النمو. ذلك أن هذه السياسات كان تعني خلق وهم بخروج الولايات المتحدة من الجيوستراتيجيا العالمية والتخلي عن العالم لخصومها الأوتوقراطيين ليعززوا سياساتهم ونفوذهم ومطامعهم. وسرعان ما تبين أن العودة للانعزالية سيكون ذلك انتحارا عبثيا ولاعقلانيا.
لقد ثبت أن سياسة كهذه ليست قصيرة النظر فحسب بل خطرة بشكل جوهري على الأمن القومي للولايات المتحدة. وثبت أيضاً أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الاحتفاظ برفاهها عبر الانكفاء في قوقعتها الجيوستراتيجية وما لم تحتفظ استراتيجياً بالموقع العالمي للدولار. فهذا ترف خطر لا قِبل للولايات المتحدة به.
لقد كانت القوى الدولية المنافسة أو التي تعيش طفيلية على الوضع الاستراتيجي الدولي سعيدة بهذا الانكفاء الاستراتيجي الأمريكي واسترسلت بالتمدد في مناطق مختلفة من العالم على مدى العقدين الماضيين سواء تعلق الأمر ببحر الصين أو بدور روسيا في أوروبا أو القفقاس أو الشر ق الأوسط أو تعلق الأمر بإيران والسلاح النووي وبقضية الإرهاب الدولي، استشرست هذه القوى في الفضاء الجيوستراتيجي العالمي وتمكنت من زعزعة خطرة لا سابق لها للتحالفات المؤسسة للنظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة. وراحت تعزز ابتزازها الاستراتيجي على عدة جبهات. في حين ذهبت الإدارة الأمريكية تعوم على تحالفات عابرة وتوافقات سطحية لا يعتد بها.
أما الآن فسيواجه الرئيس بايدن ليس فقط مهمة تدعيم المناعة الاقتصادية للبلاد بل وتعزيز المناعة العسكرية والجيوستراتيجية للأمة الامريكية. في هذا السياق سيترتب على الرئيس المنتخب الجديد التركيز على إنتاج رؤية لإعادة صياغة نظام عالمي لما بعد الحرب الباردة وإعادة تحديد موقع الولايات المتحدة من هذا النظام بالتوافق مع الشركاء في كل من أوروبا وشرق آسيا.
ذلك أن التفوق الجوهري للأنظمة الديمقراطية المتطورة لا ينبع من حجم الدخل القومي لهذه الكتلة الدولية فحسب بل والأهم من ذلك فإن تفوقها مرتبط بتفوقها العلمي في العلوم الأساسية وفي التقنيات الفائقة وفي استمرار الزواج بين طبقة رجال الأعمال والأكاديميا الغربية.
كل ذلك يمكن هذه الكتلة الدولية من تحديد معاير التطور ونماذجه المطابقة ويسمح لها بتحديد قيم هذا التطور ومعاييره. فقيمة الدولار لا تنبع من تغطية بالمعادن الثمينة بقدر ما تحكمها الثقة بقدرة الولايات المتحدة واقتصادها وتفوقها العلمي التكنولوجي.
من أجل الاحتفاظ بموقع الدولار الأمريكي بصفته معيارا لموقع الولايات المتحدة وتفوقها الدولي، كان لابد من أن تعود الولايات المتحدة لفتح أسواقها أمام الحلفاء والكف عن ابتزاز حلفائها عبر الضغط عليهم بشأن حرية وصولهم للأسواق الأمريكية، والانخراط من جديد في قيادتها لمعايير العولمة ونظامها الدولي. ليس هذا مجرد خيار مبني على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة فحسب، بل إنه خيار استراتيجي يتعلق بالأمن القومي الأمريكي وبموقعها من النظام العالمي بنسخته المستجدة.
ستكون الإدارة الجديدة إذا محكومة بإعادة بناء التوافق مع “الغرب” الاستراتيجي. إنه الممر الإجباري الذي سيحكم حقبة الرئيس بايدن بل وسيحكم عليها أيضاً. ومن دون ذلك لن يكون من الممكن مواجهة قوى معادية مثل روسيا وقوى منافسة مثل الصين.
كما تظهر أزمة التغيير المناخي وجائحة كوفيد تعبئة القوى الدولية في العقود المقبلة من دون الانخراط الفاعل والدينامي للولايات المتحدة في الساحة الدولية وإعادة رسم دوائر التحالف والتوافق عبر الانهماك والاستثمار في العمل الدبلوماسي السلمي.
يبدو أن إدارة العهد الجديد ستكون مؤهلة لأن تلعب دوراً رئيسياً في إكراه الدول المارقة التي تسعى لتقويض النظام الدولي وحملها على اعتماد خيارات تسمح بتأطير ميولها العدوانية باستخدام الأدوات الاقتصادية و الدبلوماسية.
لقد تمكنت الدبلوماسية الأمريكية بما في ذلك الدبلوماسية العسكرية الأمريكية في السابق من لجم مدهش لاحتمالات الحرب المباشرة إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي من خلال آليات غاية في التعقيد من الإغراء والإكراه. وسيتعين على الإدارة الجديدة أن تعيد التأسيس لهذه التقاليد ليس فقط لردع بل لتكريس دورها كوسيط قوي في النزاعات الدولية.
إن إعادة صياغة النظام العالمي المستجد سيتطلب بلا شك التفاوض على اتفاقات جديدة في إطار منظمة التجارة العالمية بما يضمن مصالح وتحالفات الولايات المتحدة وبما يسمح بشروط مواتية لمزاحمة مع القوى الدولية المنافسة. كما ستتطلب حماية الاقتصاد الأمريكي إشراك اقتصاديات الديمقراطية المتقدمة كحلفاء في صياغة هذه الاتفاقات.
لكن الإدارة الجديدة ستتولى مهامها وسط شكوك وقلق كبير حول مستقبل الرأسمالية الليبرالية وفساد البنية الديمقراطية. تزعزع هذه الحقيقة بشكل كبير قوة المثل يتحدث عنها بايدن والتي تستند إليها القوة الناعمة للدبلوماسية الأمريكية.
في هذه الساحة بالذات تتشابك بشكل منقطع النظير المهام الداخلية للإدارة الجديدة بالنجاح في السياسة الخارجية. وتتشابك المصالح الاقتصادية بالمصالح الجيوستراتيجية.
فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي نمت على حواف النظام الرأسمالي الليبرالي قشور من الفساد سمحت لأنظمة رأسمالية الدولة المحسوبية والدكتاتوريات الفاسدة باختراق جوهري لصلب البنية السياسية لعدد من النخب والأنظمة السياسية الديمقراطية. وتبين بشكل صارخ في العقد الماضي كيف تعمل منظومات الفساد العالمي كآلية نخر في صلب هذا النظام. لقد حققت مراكز الأنظمة الدكتاتورية اختراقا جوهريا في النظام العالمي ونمت الأوتوقراطية لتسبح أكثر ثقة بفضل صعود الشعبوية في الغرب، لا لشيء إلا بسبب تراخي مناعة ويقظة الاستراتيجية للديمقراطيات المتقدمة.
لذلك، فلو أراد الرئيس المنتخب تنفيذ تعهده بتحقيق نقلة شاسعة نحو عصر التعميم الشامل للتقنيات العالية في الصناعة والمجتمع وتطوير موارد الطاقة المستدامة إلخ.. فإن ذلك يتطلب تبدلا جذريا في العلاقة بين الإدارة الـ “وول ستريت” ذاته.
حيث ظهرت أيضا منذ نهاية العقد الماضي توجهات جوهرية في السياسة الأمريكية لضبط اقتصاد الظل وعمليات الفساد المالي الدولية. وبذلك تصبح قضية محاصرة رأس المال الرمادي والأسود وتحديد دوره السياسي ومحاربة حلقات الفساد الكونية قضية أمن داخلي أمريكي من الطراز الأول بقدر ما هي قضية جوهرية في السياسة الخارجية.